غزة وسط الدمار والإهمال: قوة المقاومة تواجه تهاون القادة
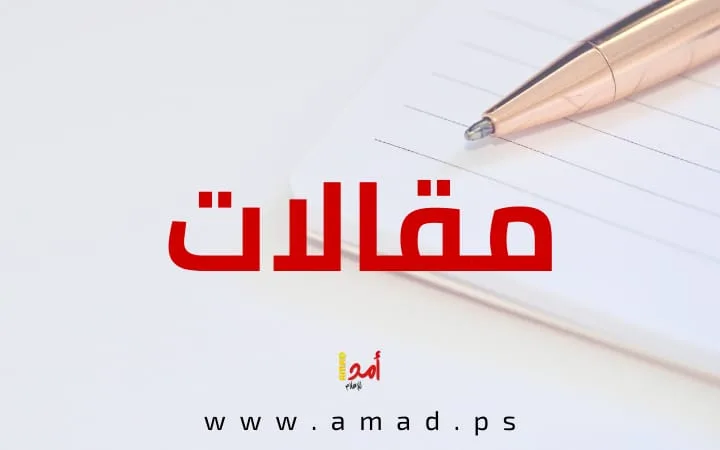
أمد/ مع اقتراب مرور عامين على الحرب، تظل غزة مشهدًا لأزمات متراكمة، حيث يترك القصف والدمار آثارًا تتجاوز الجغرافيا المادية لتصل إلى أعماق الهوية الاجتماعية والنفسية للسكان. الحرب لم تقتصر على تدمير المنازل والبنى التحتية، بل أعادت تشكيل العلاقة بين الإنسان ومكانه، فالمكان أصبح رمزًا للذكريات المؤلمة والبيت لم يعد مجرد مأوى، بل خزانًا للغياب والألم. في ظل هذا الواقع، يظهر التهجير كأداة ليست مجرد خيار عسكري، بل كجزء من مشروع أوسع لإعادة تشكيل المجتمع وفق موازين الخوف والحرمان.
الفقد اليوم ليس فقط فقدان الممتلكات، بل فقدان الحماية والهوية والانتماء. الأفراد الذين فقدوا منازلهم أو اضطروا للنزوح، يواجهون أزمة مزدوجة: فقدان المكان وتهديد استمرارهم كجزء من النسيج الاجتماعي. مع ذلك، تصمد الحياة اليومية كخط دفاع رمزي، حيث تتحول أفعال بسيطة مثل إعداد الطعام، تعليم الأطفال، مشاركة الموارد، أو الحفاظ على مراكز الإيواء، إلى ممارسات مقاومة تضمن استمرار الذات والمجتمع على الرغم من التفكيك المتعمد للبنية الاجتماعية. هنا، المقاومة لا تُقاس بالسلاح أو المساحات المستعادة، بل باللحظات التي يرفض فيها الإنسان أن يُمحى، ويؤكد أن وجوده وكرامته يستمران رغم الظروف القاسية.
التحدي الأكبر يكمن في أن هذا التهجير لن يكون ممكنًا فقط بالقصف، بل عبر استغلال الفراغ المؤسساتي والهشاشة الاجتماعية. وهنا يظهر دور أصحاب القرار والقيادة الفلسطينية بشكل حاسم. غياب استراتيجية واضحة، الانقسامات الداخلية، الانشغال بالحسابات السياسية أو الخطاب الرمزي، كلها عوامل تزيد من هشاشة المجتمع أمام محاولات الاحتلال للتهجير التدريجي. إذا لم يرتقِ دورهم لمستوى التحدي، فإن المخاطر تتحول من احتمال إلى واقع، ويصبح التهجير أمرًا عمليًا أكثر من كونه مجرد تهديد.
مواجهة هذا الخطر تتطلب قيادة سياسية واعية، قادرة على ترجمة صمود المجتمع المدني والمبادرات المحلية إلى استراتيجية شاملة. يشمل ذلك الحماية القانونية، الضغط السياسي والدبلوماسي، إدارة الموارد والإغاثة، وتنسيق المبادرات المجتمعية بشكل يمنع الفوضى واستغلال الحاجة الإنسانية. التمسك بالمكان، الحفاظ على روابط التضامن، ودعم المبادرات المحلية الذكية، كلها أدوات فعّالة، لكنها ستظل محدودة إذا لم تصاحبها قيادة نشطة وحازمة.
كما يبرز الخطر في أن التهجير لا يضر فقط بالمكان أو السكان، بل بالهوية الجامعة للمجتمع الغزي. فقدان السكن المستقر يولد شعورًا بالخذلان، ويعزز الفردانية والنجاة الشخصية على حساب التضامن الوطني. إن مقاومة هذا المشروع تتطلب تعزيز الانتماء المحلي والوطني معًا، واعتبار كل فعل يومي، من الحفاظ على الروابط الاجتماعية إلى التوثيق والمبادرات الثقافية والتعليمية، جزءًا من استراتيجية أوسع لمواجهة التهجير.
في النهاية، الصمود في غزة ليس مجرد مقاومة للبقاء البيولوجي، بل هو فعل سياسي واجتماعي وثقافي. كل يوم يثبت الناس فيه وجودهم، ويعيدون بناء حياتهم ومجتمعهم، يشكل خطوة في مواجهة مشروع التهجير. لكن هذا الصمود يحتاج إلى قيادة تتفهم الواقع، تتجاوز الانقسامات، وتضع الاستراتيجية الواقعية فوق أي حسابات رمزية أو سياسية. فبدون ذلك، يصبح خطر التهجير أكثر قربًا، بينما يصبح الصمود مجرد مقاومة فردية، غير قادرة على حماية الأرض والمجتمع من التفتت والانحلال.
