في سوريا، لا يوجد حل عسكري سواء داخلياً أو خارجياً.
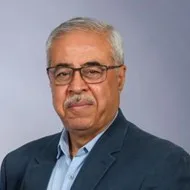
للمرة الثانية، منذ انهيار نظام الأسد (أواخر العام الماضي)، دخلت سوريا في موجة جديدة من العنف، أو الاقتتال الأهلي، الأمر الذي يعوق بناء الدولة الجديدة، ويصدع الوحدة المجتمعية، لشعب هو أحوج ما يكون إليها، بالنظر لما عاناه خلال الـ 14 عاماً الماضية، من قتل وتدمير وتشريد، في ظل النظام السابق، الذي حكم بالحديد والنار لأكثر من خمسة عقود. ما فاقم الأمر هذه المرة، بالقياس لموجة الاقتتال في الساحل (آذار/مارس الماضي)، أن الأحداث تركزت في مدينة السويداء، أي في بيئة معارضة للنظام السابق، ومؤيدة للثورة السورية، وكانت رفضت إرسال أبنائها للالتحاق بجيشه، واعتبرت موطناً للنازحين من الأرياف المجاورة لها، ونظمت عصياناً مدنياً استمر لعامين. بالنتيجة فإن هذا الاقتتال، في هذا الخيار الأمني الذي تبنته الدولة، عن قصد أو من دونه، أدى إلى إحداث شرخ بين الجمهور “الدرزي” في سوريا، الذي وجد نفسه في دائرة الاستهداف أو التهميش، كما أدى، أيضاً، في ظل التحشيد، إلى عزل أدوار الشخصيات الوطنية – المدنية السياسية والثقافية الدرزية، لصالح القيادة الروحية، التي يمثلها الشيخ حكمت الهجري، وهو الأمر الذي حذر منه الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط. من ناحية ثانية، فهذه المرة ثمة عنصر خارجي هو إسرائيل شجع على عملية الاقتتال، من خلال توجيه ضربات للقوات الأمنية حول السويداء، وعبر قصف بعض المواقع السيادية في العاصمة دمشق، مع ادعائها القيام بذلك بدعوى حماية الأقليات، واستجابتها لمطالب بعض الدروز من مواطنيها الفلسطينيين، وفي هضبة الجولان السورية المحتلة، وفي السويداء (في إشارة للشيخ حكمت الهجري)، علماً أن إسرائيل تضطهد الأقليات فيها، وتعتبرهم، بمن فيهم “الدروز” مواطنين من درجة دنيا، وهو ما أكدته بتشريع الكنيست لاعتبار إسرائيل بمثابة دولة قومية للشعب اليهودي (2018). الفكرة أن إسرائيل تحاول استغلال المرحلة الانتقالية في سوريا، وضعف إمكانياتها، لفرض الإملاءات عليها، سواء بفرض منطقة آمنة تمتد لعشرات الكيلومترات في العمق السوري، إلى حدود محافظة دمشق، ما يشمل محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء، وأيضاً فرض استطالات لها في سوريا، بدعوى إقامة كيانات سياسية على خلفيات طائفية وإثنية، شبيهة بها كدولة طائفية – يهودية، ما يجعل دول المشرق العربي تتطبع بطابعها، وهذا حاصل في لبنان منذ تكوينه الأول، كنظام مبني على الديموقراطية التوافقية – الطائفية، وما ترتب في العراق بعد الغزو الأميركي (2003)، بحيث بقي فرض الأمر في سوريا. الناحية الثالثة، التي أدت إلى تفاقم الوضع، تمثلت بما أطلق عليه “فزعة العشائر”، إذ تسرعت القيادة الانتقالية في سوريا بالسماح به، لأن ذلك يشرعن الحرب الأهلية، كسوريين في مواجهة سوريين، ويؤجج التصدعات الطائفية ـ الإثنية، الهوياتية في مجتمع السوريين، فضلاً عن أن ذلك يتناقض مع سيادة الدولة على أراضيها، واحتكارها للسلاح، ونزع أسلحة كل الفصائل، وكلامها عن توحيد السلاح، وجعله تحت القانون. الآن، ربما يجب إدراك أن العشائر من مكونات ما قبل الدولة، وما قبل المواطنة، مثلها كالبنى الطائفية والإثنية، أما بروز ظاهرة العشائر، وهي مجموعات غير مترابطة، فهو أحد نتاجات افتقاد السوريين لمكانة المواطن وحقوق المواطنة والمجتمع المدني، ونتاج المحو السياسي في المجتمع السوري، ونتاج حرمان مناطق واسعة في سوريا في الشرق والشمال والجنوب من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، ونهب خيراتها، ونتاج نقص التمدين، والتعامل مع السوريين بوصفهم مكونات طائفية وإثنية وعشائرية، ونتاج مركزية الدولة القائمة على الاستبداد والفساد لأكثر من خمسين عاماً. وفي كل ذلك فإن أبناء العشائر هم ضحايا أيضاً، ضحايا السياسة والجغرافيا والتاريخ، وضحايا الحرمان والاستبداد والقهر وفقدان حقوق المواطنة كغيرهم من السوريين. وبكل الأحوال فإن العصبيات الطائفية والقومجية والعشائرية والأيديولوجية، كلها عصبيات عمياء، ومضرة، ودلالة على فشل تاريخي في بناء الدولة والمواطنة، لذا فإثارة هذه العصبيات ووضعها في مواجهة بعضها بمثابة وصفة للحرب الأهلية، وخراب الدولة والمجتمع. في الواقع، فإن الشعب السوري في أحواله الصعبة الراهنة ليس بحاجة إلى حلول أمنية لمشاكله الداخلية، وليس بحاجة لاستدعاء التدخلات العسكرية الخارجية، بقدر ما هو بحاجة إلى الحوار والحلول السياسية الوسط والتشاركية، على قاعدة التعايش والقبول المتبادل، والتأسيس على أن سوريا واحدة بشعب واحد، من مواطنين أفراد، وأحرار، ومتساوين.
