محمد رمضان الملوي لـ’النهار’: الترجمة كأداة ثقافية تُعزز الأصوات المهمشة

عشرون عنواناً ترجمها محمد رمضان الملوي من الألمانية إلى العربية، كان آخرها كتاب “الليل” الذي يقع ما بين خفايا الليل، وتلك الأسرار التي تحدث في ثناياه، ما بين شعرية اللغة، وحس المؤلف، بل وتلك الروح التي تتماهى مع أصل النص وفحواه، تتأكد ماهية المترجم، حيث التزام النص الأولي بلغته الأم وصبغته، برؤية تعمق من معاني المطروح، فكرياً وبلاغياً، وكذلك جمالياً.
*بعد عشرين عنواناً في الترجمة من الألمانية إلى العربية، لماذا كان كتاب “الليل”؟
– إنّه عالم موازٍ سبر أغوار الليل بصفته ظاهرة طبيعية وثقافية ونفسية، عبر عدسة تاريخية وأنثروبولوجية وأدبية. قدَّم خلاله الكاتب الألماني بيرند برونر رؤية بانورامية حول تحوّل الليل من لحظة خوف وغموض إلى زمنٍ للأحلام، والإبداع، والحرية، وللانحرافات أيضاً.
وصف المؤلف الغسق من منظور تأملي شاعري، وعاد إلى عصور ما قبل التاريخ ليشرح كيف كان الليل من دون نجوم أو قمر أو بشر. ثم استعرض تطور علاقة الإنسان بالليل من الخوف إلى التدجين عبر النار، ثم الاختراق العنيف بظهور الضوء الاصطناعي.
الكتاب ليس تأملاً فلسفياً في الليل فحسب، بل أيضاً سجل تاريخي لتطور علاقة الإنسان بالزمن المظلم. يتضمن معلومات علمية ميسّرة، واستبصارات أنثروبولوجية غير مألوفة، ويربط بين الحياة الحديثة والموروثات القديمة.
كتاب “الليل“، ترجمة محمد رمضان الملوي.
* وما هي السطوة/ الشغف/ الدافع لترجمة هذا العمل، هل هو شخصاني/ فلسفي/ ذاتي وجودي، وماذا يمثل لك هذا العنوان؟
-أحب الحكايات، وهي طريقتي المثلى للتعلم والتعليم، وقد أسست قبل سنوات مبادرة باسم “خميرة الحكايات” بالتعاون مع وزارة الثقافة، قدمت خلالها للأطفال والكبار أكثر من مئة حكاية، منها مثلاً “السيرة الظاهرية” و”حكاية حجر رشيد” و”سندريلا المصرية” وغيرها الكثير، ومنذ القِدَم الليل هو منشأ الحكايات ومصدرها؛ فيه تحدث، وخلاله يتناقلها المتسامرون.
وقد وقعت في حب هذا العمل لما وجدت أنّ مؤلفه اعتمد على أسلوب موسوعي، لكنه في الوقت نفسه بعيد عن الجفاف الأكاديمي؛ بل دمج الحكايات بالأمثلة والاقتباسات الأدبية والتأملات التاريخية كما وظف أيضاً النوادر الطريفة.
كتاب “الليل” ليس كتاباً عن النوم فقط، بل عن حكاية الإنسان في الليل؛ كيف يعيش، ويحلم، ويخاف، ويتذكر، ويبدع. أعاد بيرند برونر للّيل مكانته الرمزية والثقافية بعد أن أضعفته أنوار المصابيح وشاشات الهواتف.

المترجم محمد رمضان الملوي.
* في ما خص مبادرتك “خميرة الحكايات”، ما الرابط بينها وبين الترجمة، وما الذي يدفع بمترجم إلى ممارسة الحكي؟
– نحو نصف ما قدمته من أعمال مترجمة كان موجهاً إلى الأطفال والناشئة، فقد ترجمت مجموعة حكايات شعبية من البلدان الناطقة بالألمانية صدرت على مدار سنوات في سلسلة الأدب العالمي للطفل والناشئة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهي تخاطب الشريحة العمرية تحت سن 12 عاماً، منها مثلاً العناوين التالية: “الناي الذهبي”، و”الطاحونة المسحورة”، و”عصفورة تبيض ذهباً”، و”حكاية الخزافين”.
كذلك ترجمت بعض القصص الطويلة والروايات للناشئة فوق 12 عاماً، أهمها رواية “ملحمة الذئاب” للكاتبة النمسوية كيتي ريشايس الصادرة عن سلسلة الجوائز في هيئة الكتاب عام 2015، والحاصلة على جائزة الوسام العالي من الأكاديمية الألمانية لأدب الشباب والأطفال، وهي أعلى جائزة في ألمانيا تُقدم الى تلك النوعية من الكتب. بالإضافة إلى ترجمتي لبعض الأعمال الحديثة في مجال الثقافة العلمية وتبسيط العلوم.
ولكن مع كل هذه الترجمات لا أرى أن الفائدة تكتمل من دون تواصل حقيقي مع تلك الفئة، وهكذا فلا يليق بالمثقف الفاعل اقتصار عمله على مجرد الإنتاج الفكري من دون ممارسة دور نشط ومؤثر في المجتمع، ويتضمن هذا الدور المساهمة في تشكيل الوعي العام، والمشاركة في التغيير الاجتماعي. وقد ساهم بشدة التواصل الحقيقي المباشر أثناء جلسات الحكي في تطوير ترجماتي التي أعمل عليها وتقديمها بصورة أفضل.
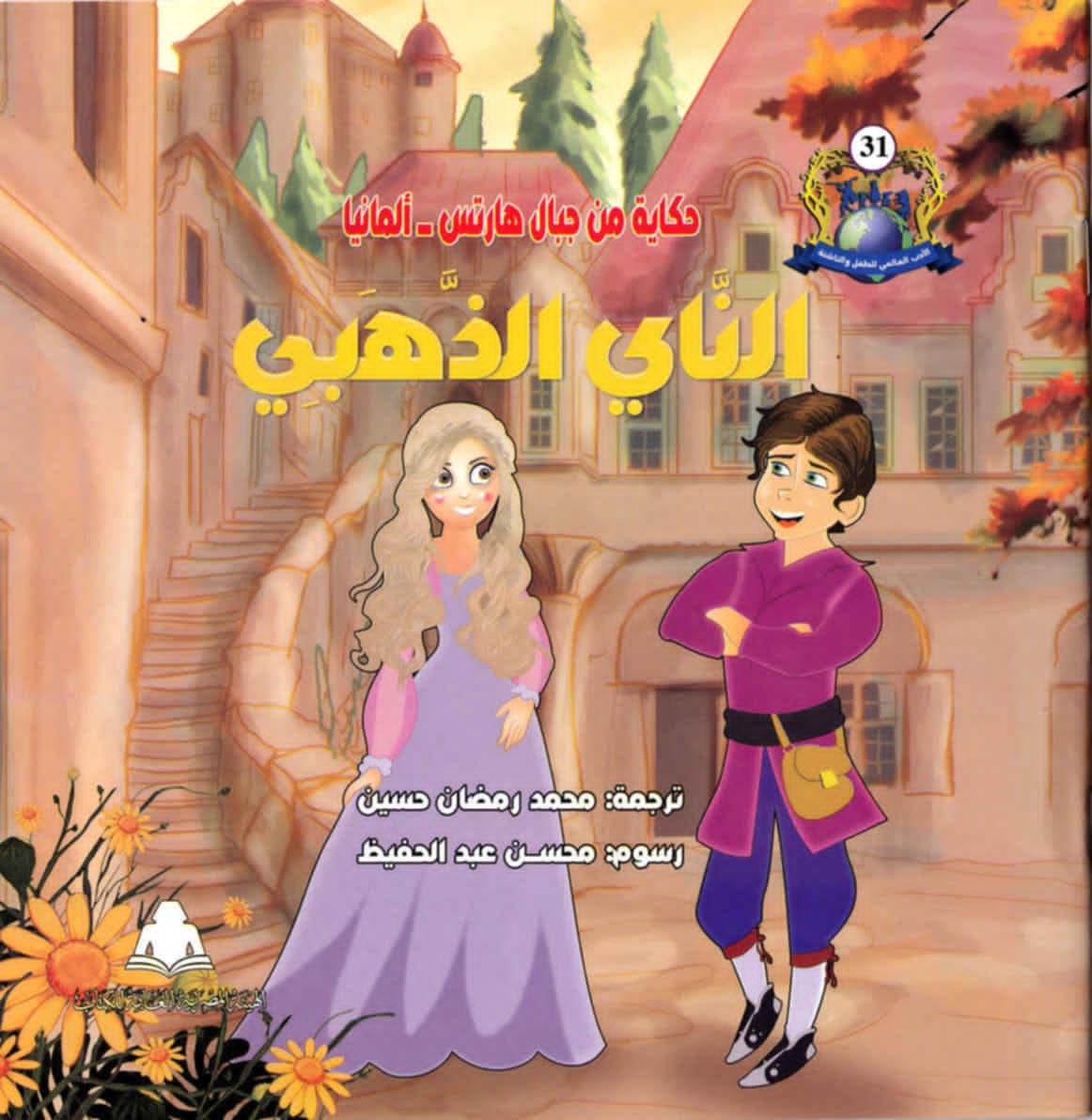
غلاف كتاب “الناي الذهبي“.
*وصل كتابك ما قبل الأخير وعنوانه “عصر الضبابية؛ سنوات الفيزياء الساطعة والمظلمة”، إلى القائمة القصيرة لجائزة سميرة موسى للترجمة في مجال الثقافة العلمية وتبسيط العلوم من المركز القومي للترجمة. ماذا عن ظروف هذا العنوان وملابساته في ما خص عدم نيله الجائزة، وهل ثمة عتبات تتكئ عليها لجان التحكيم بشكل عام لمنح الجوائز وحجبها؟
– غاية ما يتمناه المترجم هو تقديم عمل المؤلف على الوجه الذي ارتضاه حين كتبه، لذا تجدهم أحرص ما يكون على الحضور الشبحي خلال العمل المترجم تشعر بهم لكن لا تراهم، تصلني كل يوم جوائز عديدة من أشخاص لا أعرفهم يتناولون أحد أعمالي بالمديح أو يكرمونني بتبصرتي ببعض الملاحظات فأدين لهم بالفضل.
لم أتقدم الى الجائزة لكنها كانت خطوة طيبة من الناشر، ولم أعرف بوصول الكتاب إلى القائمة القصيرة إلا من خلال منشور لصفحة المركز على “فايسبوك”، ثم اتصال دعوة إلى حضور حفل بسيط يوم التروية في المركز اقتصر على مشاركة الفائزين والقوائم القصيرة وبعض المحكمين والناشرين، وانتهى من دون صدى إعلامي لكنه كان فرصة طيبة للقاء بعض الزملاء الأفاضل.
وكتاب “عصر الضبابية” للباحث الألماني توبياس هورتر يمتاز بأسلوب فريد مزج بين العمق العلمي والسرد الحكائي الجذاب، اذ لا يقدّم المفاهيم الفيزيائية الكبرى – كميكانيكا الكم والنسبية ومبدأ عدم اليقين – في صياغات مجردة أو معادلات معقدة، بل دمجها في حكايات إنسانية حية، تدور حول لحظات فاصلة في حياة العلماء. فنقرأ فيه مثلاً عن معاناة ماكس بلانك في الوصول إلى صيغة الجسم الأسود داخل غرفة معتمة، أو اضطراب أينشتاين وهو يركض بمظروف إلى مكتب البريد يحمل نظريته عن الضوء الجسيمي. بهذه الطريقة، تتحول الأفكار العلمية إلى دراما بشرية يمكن للقارئ العام التعاطف معها، وفهمها ضمن سياقها النفسي والاجتماعي والتاريخي، من دون أن يُفقدها ذلك عمقها النظري أو قيمتها المعرفية. وربما يكون من أفضل الكتب التي قرأتها وجمعت بين تاريخ العلم وحكايات العلماء ورؤية فلسفية للمعرفة.
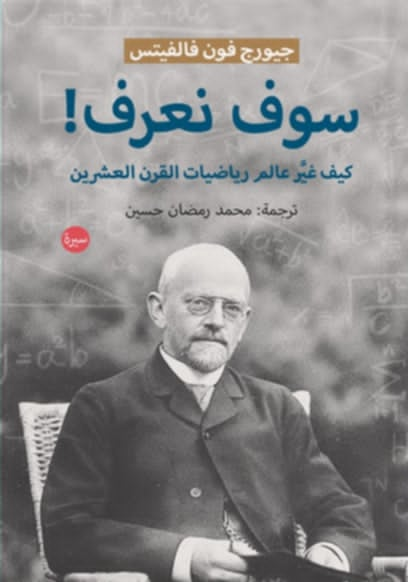
غلاف كتاب “سوف نعرف!“.
*وبعد كل تلك السنوات في مسار مع عالم الترجمة، كيف ترى حصاد هذا المسار؟
– من لطائف الأمور أن تكون أدوات الكتابة وأوعيتها من الأقلام وأحبار وأوراق تعتمد على الأشجار في أصل صنعها، لذلك دائماً ما يلوح في خاطري حديث الرسول “إذا قامت الساعةُ وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها”، أنه أكثر ما ينطبق على مهن الكتابة والتعليم تماماً كما يبدو من ظاهره قصد الزراعة والإنبات، ففي ظني أن المترجم يحمل مسؤولية كبيرة نحو أبناء بلده والناطقين بلغته وعليه أن يكون أهلاً لتلك المسؤولية باختياراته الموفقة التي تضيف إلى ثقافة قومه، أو هكذا تعلمنا في الأزهر الشريف. والحصاد يكون تراكمياً ونتيجة لجهود كل العاملين في هذا الحقل على مدار السنوات، ويتجلى أثره في نهضة علمية وثقافية شاملة.
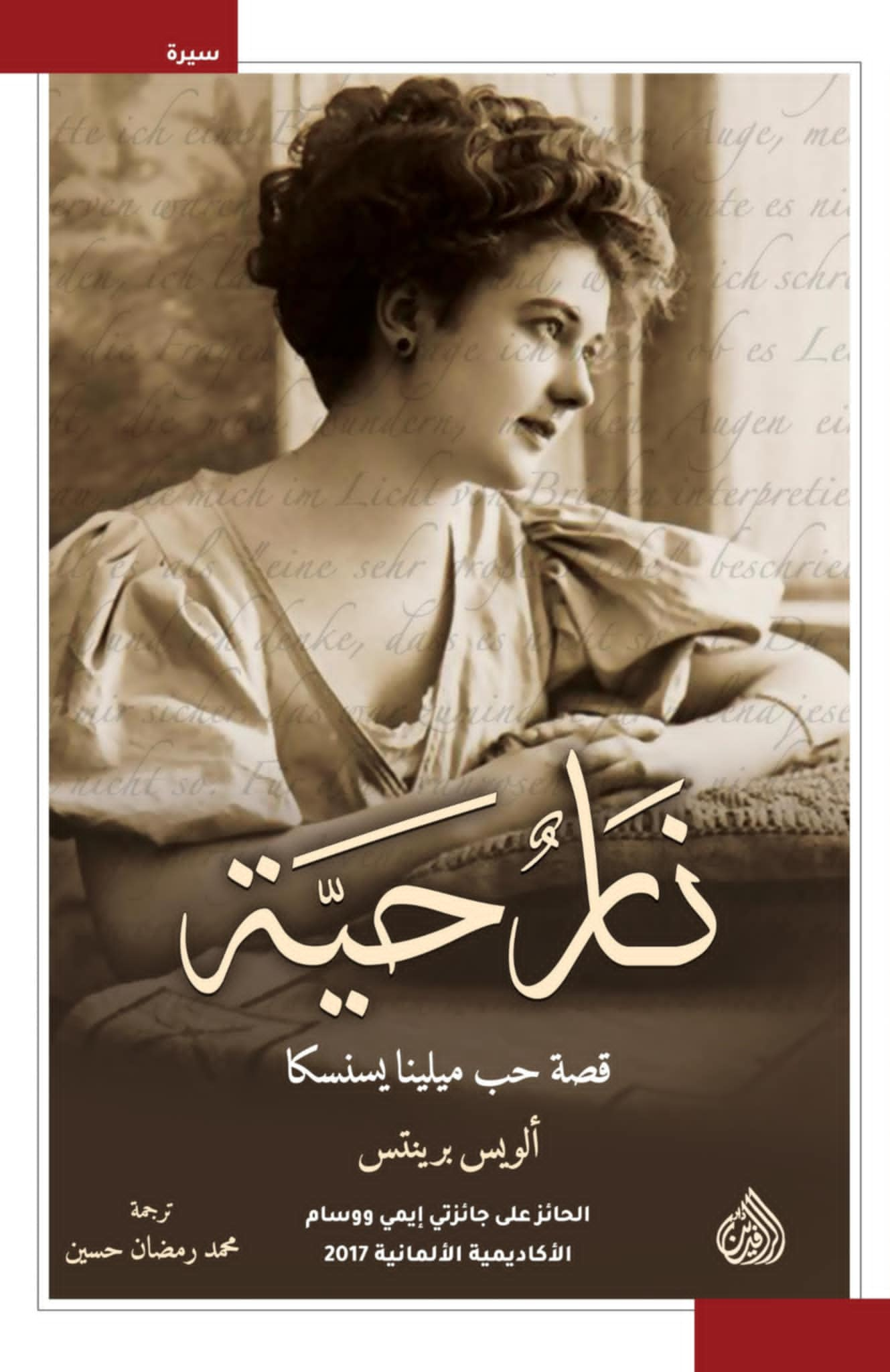
غلاف كتاب “نار حيّة“.
*تخرجت في جامعة الأزهر قسم اللغات والترجمة واخترت الألمانية؛ لماذا هذه اللغة تحديداً؟
– كان اختياري لدراسة اللغة الألمانية هو شغف التعرف إلى هذه الثقافة المهمة في تاريخ البشرية، والتي أنتجت أعمالاً فكرية عظيمة وعقولاً لامعة، كذلك أيضاً الجهود الألمانية الكبيرة في دراسة التراث الثقافي العربي، والمنهجية العلمية الدقيقة في عرض المواضيع ونقدها وتحليلها.
* في ظل الحروب، عبر الهويات/ الديانات/ المعتقد/ وحتى الجغرافيا السياسية، كيف ترى الجدوى من ترجمة الآداب والفنون؟
– قد يبدو الاشتغال بترجمة الآداب والفنون ترفاً أو عملاً غير ذي جدوى أمام شراسة الواقع في ظل الحروب والنزاعات. لكن الحقيقة أن الترجمة الأدبية والفنية تكتسب في مثل هذه السياقات قيمة مضاعفة من حيث الوظيفة الأخلاقية والثقافية.
نحن لا نترجم لغة فقط، بل نترجم تجارب بشرية، آلاماً وآمالاً وأحلاماً مكتوبة بلغة مختلفة لكنها مألوفة إنسانياً. وهذا كفيل تقويض الصور النمطية وبناء جسور التفاهم والتعاطف، خصوصاً حين يعجز السياسي عن بنائها. تدوّن ترجمة الآداب والفنون من مناطق النزاع ما يُعرف بـ”الذاكرة البديلة”، تلك التي لا تسعها البيانات الرسمية ولا الروايات المنتصرة. هنا تصبح الترجمة مقاومة ثقافية، تنقذ الصوت الهامشي وتمنحه حق البقاء والنفاذ إلى الضمير العالمي.
قد لا تغير الترجمة مسار معركة، لكنها تغيّر شيئاً في وعي القارئ. وقد لا تمنع قصفاً، لكنها تمنع التعميم والتجريد ونزع الصفة البشرية عن الآخر. وحين تُخرِس الحرب الأصوات، فإن الترجمة تعيد الكلام. بحيث تمنح مساحة للشهادات، وللقصص الفردية، وللمقاومة عبر الحكي. إن نقل هذه التجارب الى لغات أخرى هو، في جوهره، نفيٌ للصمت الذي تحاول الحروب فرضه على ضحاياها.
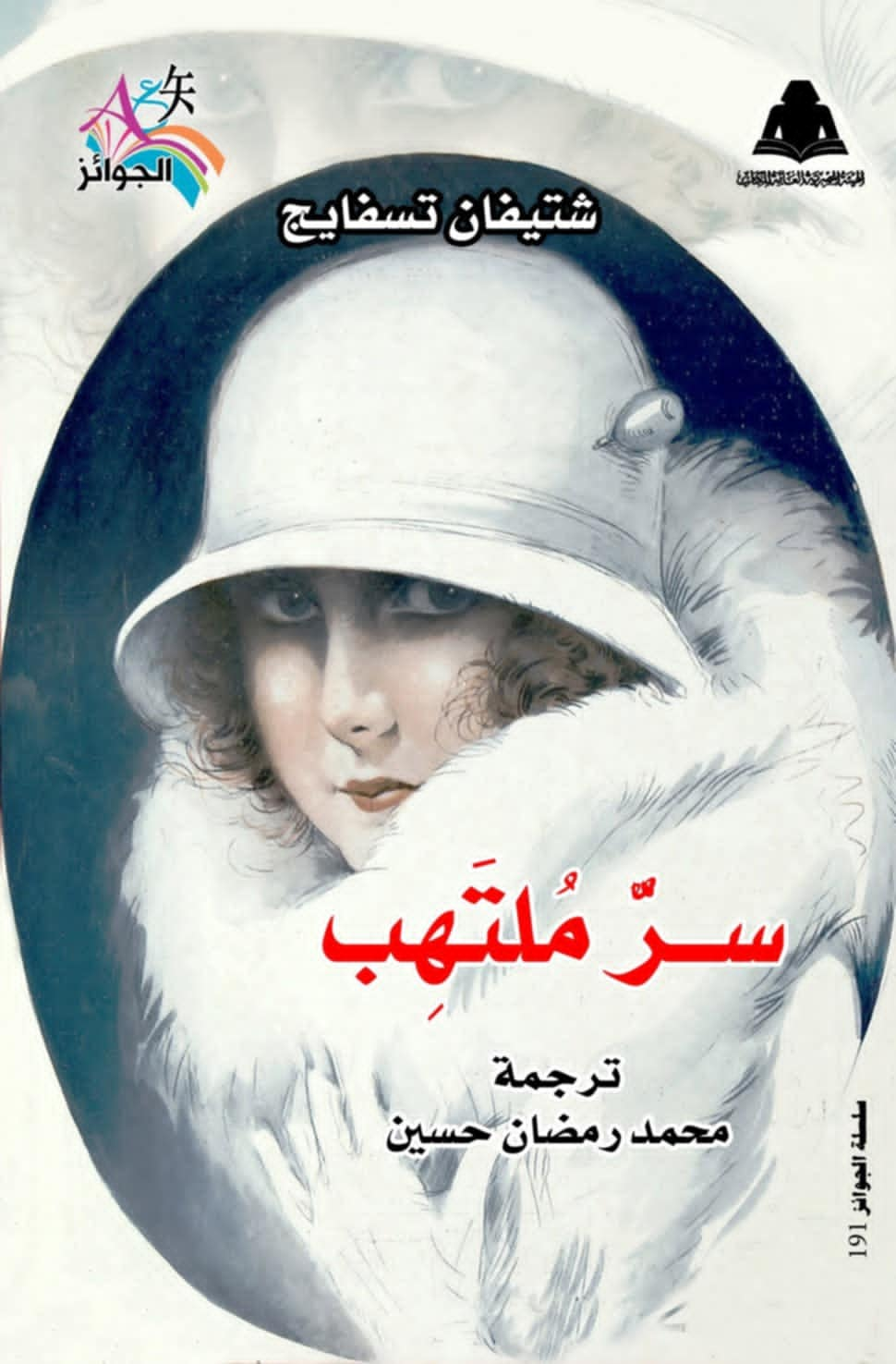
غلاف كتاب “سرّ ملتهب“.
* بعد سيطرة عوالم الصورة و”السوشيل ميديا” وطغيانها، على الفضاءات والنوافذ الثقافية، كيف ترى مستقبل الترجمة/ الكتاب/ المطبوعات الورقية؟
– صحيح أن عوالم “السوشيال ميديا” طغت على الفضاء الثقافي، لكنها لم تُلغِ الحاجة إلى الكتاب، بل أعادت طرحه بصيغ جديدة. ما نشهده ليس نهاية الكلمة، بل انتقالها من شكلٍ إلى آخر، ومن وسيطٍ إلى آخر. الترجمة، بهذا المعنى، ليست ضحية التحوّل، بل إحدى أطرافه؛ إذ تنتقل تدريجاً إلى الفضاء الرقمي، عبر الكتب الإلكترونية والمقاطع الصوتية والمرئية، من دون أن تفقد جوهرها التأويلي.
التحدي الحقيقي للترجمة اليوم هو صراعها مع ثقافة الاستهلاك السريع للمحتوى. جمهور “السوشيل ميديا” يريد “الخُلاصة”، لا قراءة معمقة. لكن هذا لا يعني استحالة الترجمة، بل الحاجة إلى تنويع أدواتها.
في عصر الصورة والسرعة، يفقد الورق شيئاً من حضوره، لكنه لا يفقد ضرورته. والكتاب المترجم قد يخرج من هيئة الكتاب التقليدي، لكنه سيظل أحد أعمدة التلقي الثقافي. المستقبل لا يُقصي أحداً، بل يعيد ترتيب المساحات والوسائط، ويبقى القارئ الجاد والمترجم الواعي ضمير هذا التوازن الممكن.

المترجم محمد رمضان الملوي.
* ولماذا إذاً تحتجب الألمانية وترجماتها في المشهد/ الخريطة الثقافية العربية/ المصرية، وهل للثقافة الأميركية/ والأنغلو ساكسونية دور في هذا الاحتجاب، وهل هناك تعمد لذلك من القائمين على التثقيف في مصر؟
– الألمانية ليست لغة دارجة أو منتشرة في الفضاء العربي مثل الإنكليزية أو الفرنسية. وتعقيداتها البنيوية والنحوية تجعلها أصعب في الترجمة. كما أن عدد المترجمين المؤهّلين من الألمانية إلى العربية قليل، ما يحدّ من تدفّق النصوص الأدبية والفكرية الألمانية.
أيضاً لا توجد في العالم العربي بنية مؤسساتية قوية ومستقرة مكرّسة لترجمة الأدب والفكر الألمانيين، كما هي الحال مع المركز الثقافي الفرنسي أو المجلس الثقافي البريطاني، بينما تبقى جهود معهد غوته محدودة غالباً ولا تواكب حجم الإنتاج الثقافي الألماني المتاح.
كذلك فإن سوق الكتاب العربي باتت (واسعة) يفضّل المضمون السهل، والرواية الخفيفة، والفكر السريع، وهي خصائص لا تنطبق غالباً على الأدب الألماني المعروف بثقله الفلسفي والنفسي، سواء مع كافكا، أو هيرمان هسه، أو حتى كتّاب القرن العشرين المعاصرين. وبالتالي لا يرى الناشرون التجاريون في ترجمته ربحاً مضموناً.
* هل للثقافة الأميركية والأنغلو-ساكسونية دور في هذا الاحتجاب؟
– الإنكليزية أصبحت لغة الهيمنة العالمية، ليس في السياسة والاقتصاد فحسب، بل أيضاً في المرجعيات الثقافية والتقنية. هذه الهيمنة تدفع الناشرين والمترجمين والمؤسسات التعليمية إلى اختيار النصوص الإنكليزية أولاً، بصفتها أسهل تسويقاً، وأسرع تداولاً، ومرتبطة بصورة الحداثة والانفتاح.
ما يُترجَم ليس مجرد اختيار فني أو أدبي، بل قرار ثقافي يعكس ما يُراد ترسيخه من نماذج فكرية وسلوكية. الترويج للأنغلو-ساكسونية (خصوصاً الأدب الأميركي) يصب غالباً في خانة دعم النموذج الفردي، الليبرالي، الاستهلاكي، وهي مضامين منسجمة مع تيارات العولمة النيوليبرالية، أكثر مما يفعله الأدب الألماني ذي النزعة التأملية أو النقدية العميقة.
وكذلك فإن المنصات العالمية مثل؛ جودريدز وأمازون ونتفليكس تلعب دوراً حاسماً في ترويج أسماء وأنماط كتابة بعينها، وغالباً ما تنطلق من الثقافة الأميركية. هذا يخلق انحيازاً تلقائياً لدى القارئ العربي حيال ما يُعرَض عليه، ويكرّس ما يُعرف بالأدب السائد.
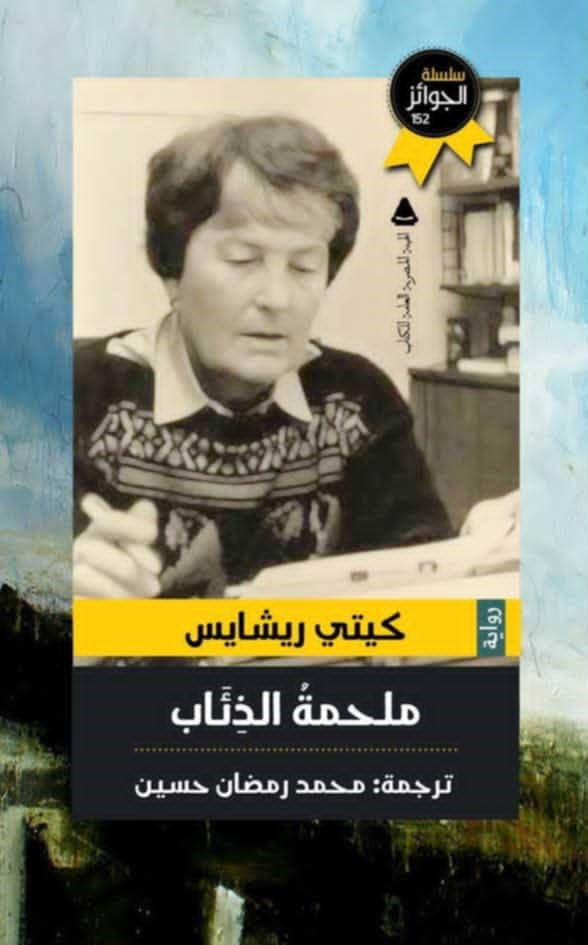
غلاف كتاب “ملحمة الذئاب“.
* هل هناك تعمُّد داخلي في التغييب؟
– في الحالة المصرية، تغيب السياسات الثقافية الرشيدة الطويلة المدى. هناك نوع من الارتجال والتكرار المؤسساتي، وضعف الاستثمار في الترجمة النوعية، خصوصاً من لغات غير شعبية كالألمانية. وغالباً ما تُدار مشاريع الترجمة بخلفيات بيروقراطية لا تراعي القيمة المعرفية بقدر ما تهتم بالكمّ أو الأسماء المكرسة.
كما أن للتاريخ دوراً أيضاً؛ فالعلاقات المتقلبة بين مصر وألمانيا عبر العقود (خصوصاً في النصف الثاني من القرن العشرين) لم تسعَ الى تأسيس شراكة ثقافية طويلة الأمد كالتي تمت مع فرنسا أو بريطانيا.
وأخيراً فإن النخب الثقافية في مصر، تميل إلى الترجمة من الإنكليزية أو الفرنسية، بسبب خلفياتها التعليمية. قلة من المثقفين هم من تلقوا تعليمهم أو ثقافتهم الفلسفية في بيئة ألمانية، ما ينعكس في نوع النصوص التي تُقترَح أو تُروج.
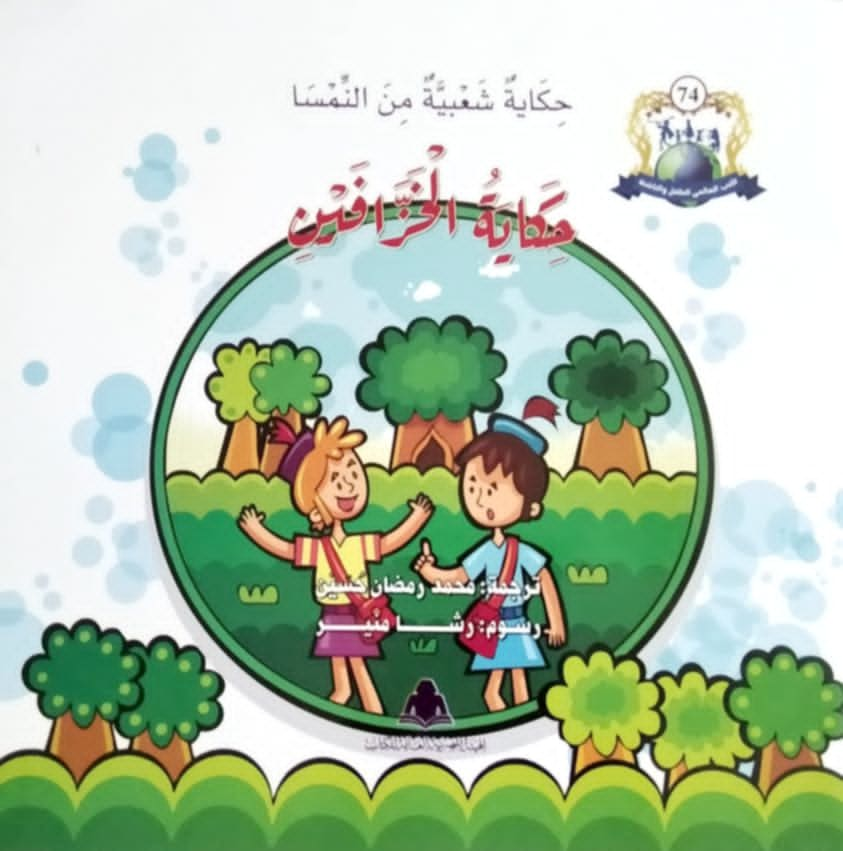
غلاف كتاب “حكاية الخزّافين“.
*تُعِدّ منذ فترة أطروحة ماجستير عن “المخطوطات”، فلماذا، وما هي الدوافع؟
-سؤال يتجاوز الشخصي إلى الجوهري، لأنه يلامس نقطة التقاء بين اللغة، والتاريخ، والمعرفة، والهوية. ويمكنني القول إن اختياري دراسة المخطوطات العربية بعد رحلة الترجمة من الألمانية لم يكن قفزاً من ميدان إلى آخر، بل هو انتقال طبيعي في طريق البحث عن المعنى العميق للثقافة، من بواباتها القديمة والحديثة.
الترجمة من الألمانية – خصوصاً في المجال الإنساني والفكري – تعوّدني على النظرة النقدية للنص، وتحليل البنية والدلالة والمقصد. لكنها تطرح في الوقت ذاته سؤالًا: أين هو النص العربي الذي يماثل هذا العمق؟ وأين هو التراث الذي يمكننا قراءته بعيون جديدة؟ وقد حدثت مقاربة معرفية في ذهني أثناء ترجمة كتاب “الليل” وقراءة كتاب “البئر” لإبن الأعرابي (المتوفى سنة 231 هـ)، هنا بدأت تلوح المخطوطات العربية كمنجم لا يزال بكراً، كنصوص لم تُقرأ بعد كما ينبغي، ولم تُفكّك أو تُأوّل بمنهجيات حديثة.
المخطوط ليس مجرد “وثيقة قديمة”، بل هو أرشيف ثقافي متكامل، يُطلعنا على آليات إنتاج المعرفة في العالم العربي، ويكشف عن بنية المجتمع، وعلاقة النص بالقارئ، ويفضح المسكوت عنه، سواء في الحواشي، أم في التملّكات، أم في التعليقات. هذا كله يجعل دراسته عملاً ثقافياً وليس مجرد تحقيق نصوص. وهو امتداد طبيعي لمن تعوّد على قراءة الفلسفة والعلوم الإنسانية من مصادرها الأصلية.
كما أن الكثير من التراث المخطوط العربي لم يُحقّق بعد، أو لم يُدرَس بنظرة كوديكولوجية أو أنثروبولوجية. ولأنني مهتم بالهامش بقدر ما أنا مهتم بالمركز، أرى أن المخطوطات – بخاصة غير الكلاسيكية أو غير المعروفة – هي أصوات صامتة من التاريخ تنتظر من يُنصت لها، لا يُعيد إنتاجها فحسب.
