“الحياة ليست قصة” لعبده وازن… رؤية الواقع من منظور حرّ.
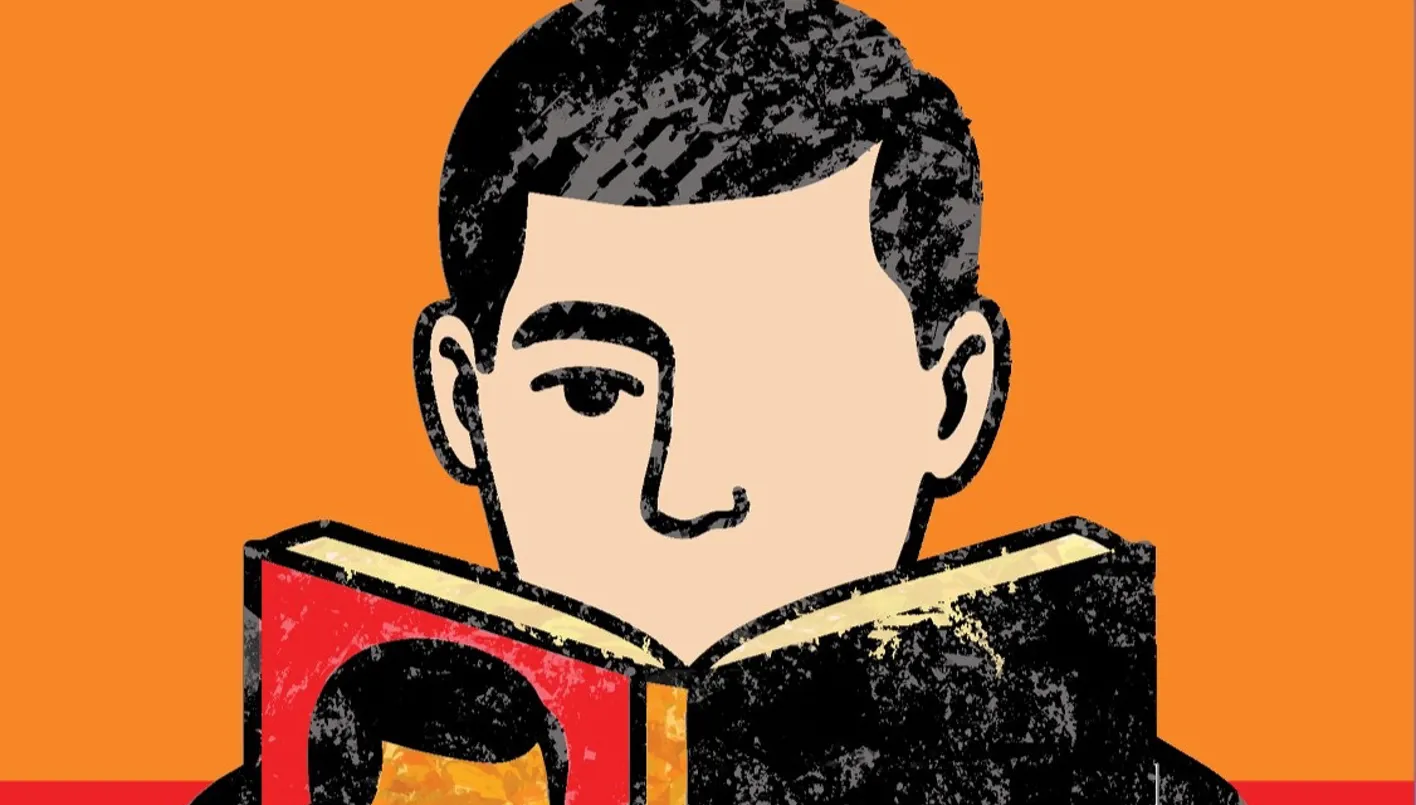
في رواية “الحياة ليست رواية”، الصادرة حديثاً عن “منشورات المتوسط” (إيطاليا) في قرابة ثلاثمئة صفحة للكاتب اللبناني عبده وازن، تتواشج توترات الأحداث المتصاعدة، والذبذبات النفسية المتأججة لدى الشخوص، والمواقف اليومية المتقلبة، والعلاقات الإنسانية العميقة والمركّبة وغير المتوقعة، لتُحدث معاً ما يمكن وصفه بالخلخلة المستمرة، بدءاً من العنوان، حتى كلمة النهاية.
هذه الخلخلة تتمثل أيضاً بوضوح على مستوى الرؤية والمعالجة والصياغة الفنية، القائمة على الانزياح والانحراف وتحدي الأفكار والتصورات التقليدية، ليس فقط بشأن القراءة والكتابة والإبداع والتثقف والمعرفة، بل بشأن التعاطي مع الواقع والسيرة الذاتية المعلنة والمشفّرة بعدسة متحررة من ميكانيكيتها وقياساتها المنضبطة، وبشأن ممارسة فعل الحياة كما ينبغي لتلك الحياة أن تُعاش وتُفهم، في الهواء الطلق، خارج أسوار الكتب.
تنسج الرواية عالمها الخاص وسط البحر المتلاطم الأمواج، بحر القراءة والصداقة والعشق وذكريات الحرب والبحث في الجذور، بغير خشبة إنقاذ واحدة لشخصياتها المحورية اللاهثة، ليبقى الصراع بينها حيّاً وأبديّاً، ولتصير الحركة إلى الأمام أملاً دائماً متجدداً، وإن كان يفضي إلى سراب، أو يقود إلى آلام وجراح ماضوية.
غلاف رواية “الحياة ليست رواية“. (دار المتوسط)
تفاعلات نشطة
ثلاثة أبطال يشكلون الأضلاع الأساسية للعمل، الأول: هو الراوي، الموصوف بأنه القارئ أو السيد القارئ، بالألف واللام، ومن دون اسم محدد، إذ إنه ليس قارئاً عاديّاً، بل الغارق تماماً في عالم الروايات والكتب والدواوين للمؤلفين العالميين والعرب، الممتهن للقراءة المنظمة كعمل احترافي “لا يتطلّب اختصاصاً ولا دراسة”، من دون أن يسعى إلى أن يكون ناقداً أو كاتباً أو يتربح من عمله، فهو يدمن القراءة بحد ذاتها، ولا يحتاج إلى المال نظراً إلى ثراء أسرته. ولكنه يتحمس في وقت لاحق لأن يتحول إلى روائي، للمرة الأولى والأخيرة، فقط ليسجل حكاية الثالوث المشحونة بالتفاصيل الثرية والمؤثرة.
الثاني: صديقه جوزف، نصفه الآخر، توأم روحه، وإن كانا بصفات مختلفة، ولكنهما يكملان بعضهما بعضاً، ويتقاسمان معاً رحلة عمرهما، خصوصاً المحطة الأخطر، وهي محطة ظهور الطرف الثالث: جوسلين، في حياتهما، ليتنافسا في عشقها، فيختار قلبها وجسدها جوزف، ولكنها تنجذب إلى صديقه القارئ برباط أقوى وأدق من أي تعريف أو تحديد، ما يخلع على العلاقة الثلاثية سحراً وغموضاً، وهذا ما يعززه أيضاً حرص الراوي “القارئ” على أن يكون مظلة حاضرة وحاضنة للعاشقين من غير أي استشعار للغيرة أو للألم، وإن كان لا يمنع نفسه من اشتهاء فتاته.
نداء الجذور
يشترك الثلاثة في أمر جوهري، إلى جانب اللحظات الراهنة المجنونة التي يعيشونها على غير قياس “ليتنا نجد من يكتب عنا رواية نحن الثلاثة، كيف التقينا وكيف أصبحنا ثلاثيّاً نادراً غير موجود في الواقع. لكننا ثلاثي غير جهنمي كما يوصف أحياناً الثلاثيّ حتى الثنائي، لا سيما في الأفلام. إننا ثلاثيّ رائع، نحب، نقرأ، نتناقش، نعيش معاً، نسهر معاً، حتى ليصعب علينا أن ننفصل واحداً عن الآخر، برغم حفاظ كل منا على مزاجه وأسراره”.
هذا الأمر المحوري المشترك هو انخراطهم جميعاً في البحث عن الجذور، وتلبية نداء الذكريات وربط إحداثيات الحاضر والماضي في منظومة متشابكة. جوسلين، مثلاً، حضرت من باريس لتلتقي جدتها أنجل، وتتعرف إلى لبنان الذي تركته مولودة صغيرة، وتتقصى آثار أبيها الذي قُتل خلال الحرب الأهلية عام 1976 “ربّما بالرصاص وربّما ذبحاً بعد خطفه على حاجز طائفي”. وهذا الأب، كانت له محبوبة سابقة، اسمها منى، تبادل معها المراسلات المثيرة، قبل زواجه من والدة جوسلين. ويقود الفضول جوسلين إلى اقتفاء آثار منى أيضاً، والتعرف إليها، والنبش في خبايا علاقتها بأبيها.
وجوزف، يكتشف أنه ابن بالتبني وليس ابناً حقيقيّاً لأبويه اللذين أمضيا عمرهما في تنشئته وتربيته، ومن ثم يسعى إلى معرفة من تكون أمه ومن يكون أبوه المتسببان في ضيعته ومأساته.
القارئ، بدوره، لا يفلت من شبح ذكرى أبيه جورج، الذي لم يكن حزبيّاً، ولم يتعاطَ بتاتاً شؤون السياسة، ومع ذلك “وقع المسكين ضحية الحرب التي شنها الجيش السوري على الأشرفية، وسُمّيت حرب المئة يوم، عام 1978. قُتل الرجل خلال هذا الحصار. كان واقفاً مع رجال أمام بوابة البناية عندما سقطَت قذيفة قربهم. مات ثلاثة منهم، ونجا واحد. قُتل الرجل ولم يُستشهد، مع أن اسمه أُدرج لاحقاً في قائمة شهداء الأشرفية”.

الكاتب والروائي عبده وازن.
اللعبة المدهشة
هكذا يصوغ الثلاثة اللعبة المدهشة بكل صراعاتها وتناقضاتها ومواقفها المرتبكة والمتقلبة، فهم يعيشون اللحظة الحالية بكل قوة وحيوية خارج الزمن، ولكنهم منغمسون في التاريخ وممسوسون بالزمن، وإن لم يكن في الرواية خط زمني مستقيم بمعنى التسلسل، إذ تتنقل الأحداث بين الحاضر والماضي وتوقعات المستقبل. وهؤلاء الثلاثة يتعاطون الحياة كما هي بوصفها حقيقة من لحم ودم وليست رواية، ولكنهم منكبون في الوقت نفسه، خصوصاً القارئ، على قراءة الروايات لجميع مؤلفي العالم من شتى العصور (دوستويفسكي، تولستوي، إرسكين كالدويل، لاكلو، نجيب محفوظ، ألبير قصيري، الخ)، ومنجرفون إلى عيش أحداثها والتماهي مع أبطالها وشخصياتها الخيالية المؤلفة.
ثم تبلغ اللعبة مداها بتصدي القارئ (الراوي) لحياتهم الثلاثية لكي يصوّرها بقلمه في رواية، بعد رحيل صديقه جوزف إثر حادث سير أليم، وعودة جوسلين إلى باريس مكلومة من غير رجعة. ويعرض القارئ، الذي صار كاتباً، مخطوطته الأوّلية بالفعل، وفق نصيحة صديقته الروائية الشابة رنا تامر، على صديق لها، شاعر، يكتب الرواية، يُدعى عبده وازن، ليقرأها ويصححها ويجعلها جاهزة للنشر! وهنا توسعة أخرى لأبجديات اللعبة، لتشمل دمج مؤلف الرواية الفعلي التي بين أيدينا أيضاً في سياق الحدث الدرامي المتنامي، وذلك لإلغاء أي فواصل وهمية متبقية بين الحقيقي والسير-ذاتي والمتخيل والافتراضي، وبين القراءة والكتابة والحياة نفسها.
مدارات التجريب
تقترح الرواية مدارات تجريبية متجاورة متحاورة، بتكنيك الرواية داخل الرواية، وبالقارئ الذي يصير سارداً لحياته وحيوات الآخرين، التي تتداخل فيها حيوات الشخوص الآتية من حصيلة قراءاته. تتقاطع الأصوات وتتنوع زوايا الالتقاط، ويصير القارئ/المؤلف جزءاً من العمل، يشارك شخصياته تحركاتها ومصائرها. تقود تلك المدارات إلى خرق السياق السردي النمطي وتفكيكه، خصوصاً مع فتح النص على الذاتي، والحضور الشخصي والثقافي والمعرفي للمؤلف، وحسه الإبداعي وذائقته الجمالية ووعيه القرائي، وهو أيضاً الشاهد الحي عبر عقود مضت على تحولات الصورة في لبنان: الحرب والحب والهوية والأدب والفكر والجدل الفلسفي والوجودي.
تأتي اللغة رشيقة، موحية، شاعرية، انسيابية، موقّعة موسيقيّاً، تأملية، مشبّعة بالتفاصيل والحوارات والمونولوجات والسرديات الدسمة، بما يلائم الشخصيات ذات الطبيعة النوعية، الملتهمة لعصارات الكتب حول العالم، والتي تحمل أبعاداً رمزية وفلسفية تُخرجها من نموذجيتها ومساراتها. وهنا، تصير القراءة الانتقائية والموسوعية في آن قوة للإنتاج وعنصراً مهمّاً في رحلة انطلاق النص، ورافداً خصباً لمد الرواية بأجواء عشرات الأعمال الغربية والعربية التي تطرح تساؤلات كثيرة حول الألم واللذة والفقد والحيرة والحب والرغبة والخوف والخذلان والغضب والانتتقام وغير ذلك من الإنسانيات، إلى جانب التساؤلات حول دور الكاتب ووظيفة الأدب وفلسفة الفن وغيرها، ما يعمّق التجربة كإعادة لفهم الذات ولتشكيل الحياة برمتها.
لقد تحول القارئ، الذي لم يطمح يوماً إلى أن يكون كاتباً، إلى روائي، يكتب بشغف من يكتب للمرة الأولى، وربما بمتعة لم يتوقعها، ومع ذلك يقول: “أشعر بألم، وربّما بأسى، فالقصّة التي قرّرتُ أخيراً كتابتها، وهي قصّتي أو قصّتنا نحن الثلاثة، أَرهقَتني ولم أجد سبيلاً للتخلُّص من هاجسها إلا عبر كتابتها. ولا يهم ألا أجيد كتابتها”.
تلك إذاً مناورة أخرى في فضاء اللايقين الكلي، الكتابة من أجل تفريغ الشحنة والتخلص من الهواجس المؤلمة والحزينة ومحو الوقائع المثبتة، وليس من أجل الإمتاع والتشويق والإجادة والإضافة. هل الرواية نفسها تدّعي أنها لا تريد أن تكون رواية بالمعنى السائد، لأن الحياة نفسها ليست رواية، أو لا تصلح لأن تُروى، ولو بألسنة أبطالها وشهودها؟
