عبد الحميد البجوقي: باب إفريقيا.. تأملات بلنسية “عندما تعيد النساء صياغة تاريخ المهمّشين والمُنسَيّين”
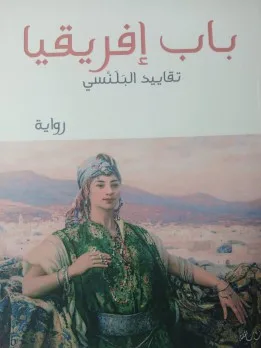
عبدالحميد البجوقي
رواية “باب إفريقيا (تقاييد البلنسي)” للكاتبة المغربية فضيلة الوزاني التهامي، الصادرة عن “منشورات باب الحكمة” بتطوان، تجربة سردية ثرية تجمع بين الذاكرة الفردية والتاريخ الجماعي، وتستعيد فترات زمنية حرجة في تاريخ تطوان والمغرب.
تبدأ الرواية من باب البحر وتكاد تنتهي من باب سبتة أو من باب خليفة السلطان. تنطلق في حبكة بديعة من منتصف القرن التاسع عشر (حرب تطوان أو “حرب إفريقيا” الإسبانية 1859–1861)، ثم تنتقل إلى بداية القرن العشرين مع الاحتلال الإسباني لتطوان سنة 1913.
في روايتها “باب إفريقيا (تقاييد البَلَنسي)”، تُقدم الروائية المغربية فضيلة الوزاني التهامي نصًا سرديًا فريدًا ينقلنا إلى قلب تطوان في لحظات حرجة من تاريخ المغرب، من خلال بناء حكائي يُزاوج بين التوثيق التاريخي والتجربة الحيّة، ويعيد للمرأة دورها كمُؤرخة خفية للتاريخ المنسي.
حين تتحوّل الحرب إلى جرح في الذاكرة
في الفصل المُعنوَن بـ”باب المقابر. الإسبانيول المحتلون” ـ ص 149 ..184ـ ، والذي يمكن اعتباره قلب الرواية النابض، نُعاين مشهدًا دراميًا مؤلمًا لسكان تطوان وهم يرزحون تحت نيران الحرب الإسبانية. فضيلة الوزاني لا تكتفي بسرد الوقائع، بل تسبر أعماق النفوس وتكشف هشاشة المجتمعات أمام العنف المنظّم. مشهد الانهيار الجماعي أمام صوت المدافع، والرجفة التي تسرق التماسك الأولي، يعكس تهاوي الحصون النفسية كما تهاوت أسوار المدينة. هنا، لا نقرأ التاريخ، بل نعيشه على جلده.
الرواية تُخرجنا من الرؤية الكولونيالية التي تعتبر الغزو لحظة سياسية فقط، وتُعيد تركيبها كزلزال نفسي، يعصف باليقينيات والأدوار والأمن الاجتماعي. فبدلاً من الحصن كرمز للثقة، يتحول إلى علامة على الخيبة والهشاشة، ويصبح الأمل ذاته سلاحًا ذا حدّين.
ما يُميز هذا الفصل – والرواية عمومًا – هو الحضور النسائي المحوري، ممثلًا في صوتَي الأم “عائشة الأندروسي” وابنتها “راوية موتريل”. تتقاطع مذكرات الفقيه سيدي عبدالله البلنسي، التي تحتفظ بها العائلة، مع تأويلات الحفيدة، لتخلق دينامية سردية مغايرة تتخطى السرد الذكوري التقليدي. النساء هنا لا يُقدَّمن كمُشاهِدات على التاريخ، بل كفاعلات ومؤرّخات يكتبن نسختهن الخاصة من الذاكرة.
يحمل اسما الراويتين، “راوية موتريل” و”عائشة الأندروسي”، رمزية عميقة ترتبط بتاريخ طرد الموريسكيين من الأندلس والشتات الذي أعقبه. “موتريل” Motril تشير إلى المدينة الأندلسية الساحلية التي كانت معبرًا لموجات المنفى بعد سقوط غرناطة، ما يجعل الاسم شُحنة دلالية على الفقد والاقتلاع القسري، وكأن الحفيدة تحمل في ذاتها ذاكرة المنفى منذ ولادتها. أما “الأندروسي”، فهو لقب يُصِرُّ على حفظ الانتماء الحضاري للأندلس، ويجسد مقاومة النسيان، حيث تظل الأم عائشة ناقلة للهوية والذاكرة الجمعية في وجه التفكك والنسيان. تتعمق المفارقة حين نجد أن هذه العائلة التي طُردت من إسبانيا تعيش بعد قرون احتلال تطوان من قِبل “أشقائهم” المسيحيين الإسبان أنفسهم الذين طردوهم من أندَلُسِهم. تكرار مؤلم لتاريخ العنف والنفي، لكن من موقع جديد. إلا أن هذا التاريخ لا يُروى هذه المرة من خلال أصوات ذكورية أو مؤرخين رسميين، بل عبر نساء يُعِدن كتابة الذاكرة، لا بوصفهن شاهدات، بل كفاعلات ومؤرّخات، تتقاطع تأويلاتهن مع مذكرات الفقيه البَلَنْسي الذي تُمثل كلماته خلفيةً باهتة لما تضيئه النساء من تجارب مسكوت عنها. بهذا، تتجاوز الرواية السرد التقليدي وتعيد تشكيله، لتجعل من الصوت النسائي محورًا للذاكرة والمقاومة السردية.
هنا تَتبَدَّى مفارقات سردية وتاريخية بارزة: عائلة طُردت من إسبانيا قبل قرون، وعاشت الشتات في شمال المغرب، وإذا بها تشهد – عبر نسائها – الحرب الكولونيالية الإسبانية على تطوان في القرن التاسع عشر (حرب تطوان 1859–1860).
المفارقة الأولى، أن من طرد الأجداد من الأندلس هو نفسه الذي يعود ليحتل شمال المغرب، فتغدو الذاكرة دائرية: الطرد من الأندلس، فالمنفى في تطوان، ثم عودة المستعمِر إلى حيث فرّ المطرودون.
المفارقة الثانية تتعلق بالنساء، تحديدًا “راوية” و”عائشة”، لا يُقَدمْن كمجرّد ضحايا لهذه الدائرة، بل كمَن يوثقنها، يؤوّلنها، ويُعِدْن سردها من منظور مختلف. إنهن لا يسردن التاريخ الرسمي، بل تاريخ الظلال، تاريخ المطرودين والمنسيين.
في هذا السياق، لا يعمل السرد على مجرد تسجيل الأحداث، بل يخلق بنية سردية مغايرة، حيث تصبح المرأة حافظة للذاكرة الجماعية والمنفى والانتماء. فمذكرات الفقيه سيدي عبدالله البلنسي التطاوني (صوت ذكوري) لا تكتمل إلا بتأويلات راوية وعائشة (الصوتان النسائيان)، وهو ما يشكّل تفكيكًا ضمنيًّا لهيمنة التاريخ الذكوري المكتوب.
“موتريل” في هذا النص الروائي البديع ترمز للمنفى والاقتلاع من الأندلس، و”الأندروسي” ترمز للانتماء المتجذر والهوية الموريسكية المُقاوِمة، والحرب على تطوان تُمثل استعادة مؤلمة لذاكرة الطرد، ولكن هذه المرة عبر أعين النساء، لا المؤرخين التقليديين. والرواية، عبر هاتين الشخصيتين، تُعيد ـ في تقديري ـ كتابة التاريخ من الهامش وبأدوات الذاكرة النسائية.Principio del formularioFinal del formulario
الخلاصة أن الأدوار تتحوَّل في هذا السرد إلى الأم التي تُنقّب عن المعنى وسط الخراب، والابنة التي تُسائل ما تبقى من تلك الذاكرة، ما يجعل من الرواية أداة لتفكيك المركزيات الذكورية في التوثيق التاريخي المغربي. عبر هذا التناوب، تخلق الروائية فضيلة الوزاني “تاريخًا آخر”، غير مرئي، تنسجه النساء بأصواتهن ومواجعهن، بعيدًا عن الأرشيف الرسمي.
الملفت كذلك للإنتباه في البناء الفني للرواية هو تحويل التاريخ من سياق خارجي مُحايد إلى شخصية فاعلة داخل السرد. لا يعود التاريخ مجرد خلفية، بل كيان يتحرك، يضغط، ويُحرّك المصائر. في هذا الفصل، تمتزج حكايات البلنسي المسجّلة في الأرشيف بأصوات الأمهات، بصراخ الأطفال، بصوت البارود، فتذوب الحدود بين ما هو توثيق وما هو تجربة.
التاريخ في هذا النص الروائي البديع، ليس كما تُوثقه المراسلات السلطانية وتقارير الأرشيف الاسباني، بل كما عاشه سكان تطوان ونواحيها.. ومن هنا، يُمكن فهم الرواية كمجال للمقاومة الرمزية، تُعيد فيه الكاتبة امتلاك سردية الغزو من خلال الذاكرة اليومية والهشاشة البشرية، لا من خلال بطولات مُخترعة، هزائم مدوية، أو وقائع جافة.
نهاية تُشرِّع أبواب التأويل
تنتهي الرواية بمشهد رمزي بامتياز (ص 313، 314)، رَاوْية تقف أمام أبواب تطوان مجددًا سنة 1913، تحت الحماية الإسبانية، في وضع انتظاري مشحون بالأسئلة. لا تقدم الرواية خاتمة تقليدية، بل تترك باب التأويل مفتوحًا، كما لو أن الرواية تقول: “ما زال التاريخ قيد الكتابة”.
هذا التعليق الزمني يُحيل إلى حالة من التشظي والارتباك السياسي التي عاشها المغرب في تلك الحقبة، لكنه أيضًا يستدعي القارئ ليتساءل: هل نحن نكتب تاريخنا حقًا؟ أم أننا ما زلنا أسرى لِنُسخ باهتة منه صيغت تحت وقع الاحتلال أو الإهمال؟
“باب إفريقيا” ليست مجرد رواية تاريخية، بل عمل إبداعي مركّب يُعيد ترتيب العلاقة بين المرأة والتاريخ، بين الحرب والذاكرة، بين الأرشيف والعيش.
اختارت فضيلة الوزاني التهامي أن تنقل صوت الذين صمتوا طويلًا – نساء، أطفال، فقراء – وتُلبسهم دور الساردين.
من خلال سرد مزدوج، ونهاية مفتوحة، ولغة مشحونة بالرموز والوجدان، تمنح الرواية للقارئ تجربة تتجاوز المتعة الأدبية، إلى مساءلة الواقع والتاريخ والهوية. إنها رواية تفتح أبواب المقابر لا للبكاء، بل لفهم ما لم يُكتب بعد..
