السامية: من اللغة إلى الفكر.. هل يمكن أن يكون العرب غير معادين للسامية؟
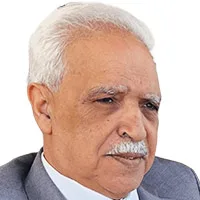
يحمل مصطلح «السامية» (Semitic) تاريخًا معقدًا ومتعدد الأوجه، يتجاوز كونه مجرد تصنيف لغوي ليلامس أبعادًا إثنية، وأحيانًا أيديولوجية مثيرة للجدل. لفهم جوهره وجذوره التاريخية حقًا، علينا التعمق في أصل الكلمة، وتطورها، والطرق المختلفة التي تم تفسيرها بها، وأحيانًا التلاعب بها عبر التاريخ. إن رحلة هذا المفهوم تسلط الضوء على كيف يمكن للغة أن تتشابك مع الهوية والسياسة، مما يؤدي إلى نتائج إيجابية وسلبية على حد سواء.
يعود أصل مصطلح «سامي» إلى سام (Shem)، أحد أبناء نوح في التقاليد التوراتية. وقد شكل هذا النسب التوراتي مفهومًا أساسيًا للغويين وعلماء الإثنوغرافيا الأوائل الذين سعوا لتصنيف وفهم العلاقات بين مختلف الشعوب ولغاتها. لم يكن الأمر يتعلق بالدم أو العرق في البداية، بل بالقرابة اللغوية الملحوظة.
صاغ العالم الألماني أوغست لودفيغ شلوتسر مصطلح «اللغات السامية» في أواخر القرن الثامن عشر. كان هدفه وصف عائلة من اللغات التي تشترك في سمات لغوية واضحة وسلف مشترك مفترض.
تشمل هذه العائلة لغات مثل العربية، العبرية، الآرامية، والأمهرية (الإثيوبية)، وجميعها تظهر ترابطًا قويًا في المفردات الأساسية، والقواعد النحوية، والتراكيب الصوتية. السمة المميزة للغات السامية هي نظام الجذور الثلاثية، الذي يتكون عادة من ثلاثة أحرف ساكنة تشكل أساس معاني الكلمات، مع تغير الحروف المتحركة للدلالة على أشكال نحوية مختلفة.
هذا النظام المدهش يميزها بوضوح عن اللغات الهندو أوروبية، على سبيل المثال، ويوفر نافذة فريدة على طريقة التفكير وبناء المعنى في هذه اللغات القديمة والحديثة.
بينما كانت «السامية» في البداية تصنيفًا لغويًا بحتًا، فقد توسع تدريجيًا ليشمل بعدًا إثنيًا أو عرقيًا، مما أدى إلى تداعيات تاريخية واجتماعية عميقة. هذا التحول لم يكن بريئًا، فقد تزامن مع صعود النظريات العرقية في القرن التاسع عشر، التي سعت لتصنيف البشر إلى مجموعات عرقية متميزة، غالبًا ما تكون ذات دلالات هرمية.
في هذا السياق، بدأ استخدام مصطلح «سامي» في سياق إثنوغرافي للإشارة إلى «عرق سامي» مفترض. فقد ساهم باحثون مثل إرنست رينان، على الرغم من كونه عالمًا في اللغة، في هذا الاتجاه من خلال مناقشة «الخصائص السامية» بما يتجاوز مجرد اللغة، متطرقًا إلى سمات ثقافية ونفسية مزعومة.
هذا التحول من تصنيف لغوي بحت إلى تصنيف عرقي كان إشكاليًا للغاية. علميًا، لا يوجد أساس بيولوجي لـ«عرق سامي». لقد أظهرت الدراسات الجينية خلفيات وراثية متنوعة بشكل كبير بين السكان الناطقين باللغات السامية، تمامًا كما يوجد تنوع داخل المتحدثين بأي عائلة لغوية أخرى. إن فكرة «العرق السامي» المتجانس هي بناء اجتماعي تم اختلاقه لأغراض معينة، وليست حقيقة بيولوجية.
تعد ظاهرة «معاداة السامية» (Antisemitism) من أكثر الجوانب إثارة للحيرة عند تناول مفهوم السامية، خاصة عند العرب. فإذا كان العرب واليهود ينحدرون من نسل سام بن نوح، ويتحدثون لغات سامية، فكيف يمكن للعرب أن يكونوا «معادين للسامية» بينما هم أنفسهم «ساميون»؟ الإجابة تكمن في الفهم التاريخي الدقيق لأصل المصطلح وتطوره.
صاغ فيلهلم مار هذا المصطلح في ألمانيا عام 1879. ومن الأهمية بمكان أنه لم يكن مجرد معارضة لليهود لأسباب دينية، التي كانت موجودة لقرون كـ«معاداة لليهودية» بل شكلًا جديدًا من التحيز يعتمد على فكرة اليهود كـ«عرق» متميز ودون. لقد استخدم مار ومعاصروه مصطلح «معاداة السامية» عن عمد لمنح تحيزهم مظهرًا علميًا زائفًا، وتمييزه عن الأشكال القديمة من التعصب الديني.
افترضت معاداة السامية، كأيديولوجيا عنصرية، أن اليهود، بحكم خصائصهم العرقية «السامية» المزعومة، يمتلكون سمات سلبية متأصلة تجعلهم تهديدًا للمجتمعات الأوروبية. وقد غذت هذه الأيديولوجيا الاضطهاد المنظم، والتمييز المنهجي، وفي النهاية ذريعة المحرقة (الهولوكوست)، التي راح ضحيتها الملايين بحسب دعاوى اليهود.. هنا يبرز سوء الفهم الجوهري. مصطلح «معاداة السامية» لا يعني معاداة كل من ينتمي إلى «سام» أو يتحدث لغة سامية. بل هو مصطلح تاريخي محدد للغاية، نشأ في سياق أوروبي، ويشير حصريًا إلى التحيز والتمييز والعداء تجاه اليهود. لم يتم ابتكار هذا المصطلح ليشمل العرب أو الآراميين أو أي مجموعة أخرى تتحدث لغات سامية.
لذلك، فإن القول بأن «العرب معادون للسامية» لأنهم يعارضون اليهود سياسيًا أو بسبب الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني هو تعبير غير دقيق من الناحية التاريخية واللغوية. الصراع في الشرق الأوسط له جذوره السياسية والتاريخية والاقتصادية والدينية المعقدة، وليس له علاقة بمفهوم «معاداة السامية» التي نشأت في سياق عنصري أوروبي ضد اليهود. بينما يوجد التحيز ضد العرب أو المسلمين، يشار إليه عادة بـ«العنصرية ضد العرب» أو «الإسلاموفوبيا»، فإنه لا يندرج تحت مظلة «معاداة السامية» بمعناها الدقيق. هذا التمييز ضروري لتجنب الخلط بين أشكال مختلفة من التعصب ولضمان فهم صحيح لجذور كل منها.
في الخطاب المعاصر، يُستخدم مصطلح «سامي» بشكل أساسي بمعناه اللغوي، في إشارة إلى عائلة اللغات. وقد تم إلى حد كبير تفنيد مفهوم «العرق السامي» من قبل الإجماع العلمي والأكاديمي. تستمر الأبحاث اللغوية الحديثة في تعميق فهمنا للعلاقات والتطور المعقد للغات السامية، مما يوفر رؤى قيمة حول الثقافات القديمة، والهجرات التاريخية، والتأثير المتبادل بين الحضارات. إن فهم التطور التاريخي لمصطلح «سامي» وخصوصية مصطلح «معاداة السامية» أمر بالغ الأهمية لمكافحة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية. إن إدراك أن «معاداة السامية» هي شكل من أشكال العنصرية يستهدف اليهود على وجه التحديد، وأن فكرة «العرق السامي» هي مفهوم تم تفنيده علميًا، أمر حيوي لتعزيز الفهم التاريخي الدقيق وبناء مجتمعات أكثر تسامحًا.
إن رحلة مصطلح «السامية» من مجرد تصنيف لغوي إلى مفهوم مشبع بدلالات عرقية وإثنية، وفي النهاية إلى أساس لأيديولوجية مروعة مثل معاداة السامية، بمثابة تذكير قوي بكيفية تشكيل اللغة والمفاهيم والتلاعب بها لأغراض مختلفة. بينما تظل فائدته اللغوية قائمة وثرية، فإن سوء الاستخدام التاريخي لمصطلح «سامي» في سياق «معاداة السامية» يؤكد على الحاجة الماسة لليقظة ضد الجوهرية العرقية والتحيز بجميع أشكاله. من خلال فهم تاريخه المعقد، وخاصة نشأة وتحديد مصطلح «معاداة السامية» بدقة، يمكننا تقدير الفروق الدقيقة في الهوية واللغة، والمضي قدمًا في النضال المستمر ضد التعصب في جميع أشكاله.
