د. شادن دياب تكتب: الشعر عالم يتشكل وينتزع العدم بأظافره ويضحك بشدة

تُعدّ «شِعرية الخلق» من أبرز الثيمات التى تناولها الشعراء عبر العصور، فهى ليست مجرّد موضوع شعرى، بل فعلٌ أدبيٌّ وجوديّ، يلامس جوهر الكتابة ذاتها بوصفها خلقًا جديدًا للعالم بالكلمات. فالشاعر لا يكتفى بوصف الواقع، بل يعيد تشكيله، يتجاوز المألوف، ويمنح الحياة بعدًا آخر من خلال الصورة والاستعارة والتخييل. إن الشعر بوصفه فعل خلق، يقف على تخوم الفلسفة والأسطورة، ويُشبه فى جوهره العمل الإلهى الأولى فى لحظة البدء: من العدم إلى الوجود، من الصمت إلى النطق، من الفوضى إلى المعنى.
الدكتورة شادن دياب 
هذه النزعة الخَلقيّة فى الكتابة ترتبط أيضًا بنوع شعرى خاص، هو «شعر الخلق»، حيث تصبح القصيدة نفسها مسرحًا لولادة الكون، ومختبرًا لصياغة الإنسان، ولتفكيك العالم وإعادة تركيبه. ويتميّز هذا النوع الشعرى بطابع أسطورى، وبنَفَس تأمّلى عميق، يربط بين الوجود والكلمة، بين الكينونة واللغة.
وفى هذا الإطار، يمكن أن نقرأ قصائد مثل «الخلق» للشاعر جيمس ويلدون جونسون، نجد سردًا لعملية خلق العالم، مستوحًى من الرواية فى سفر التكوين. تصف القصيدة كيف أن الله، وهو وحيد ومنعزل، خلق النور، والشمس، والقمر، والنجوم، وأخيرًا الأرض بما فيها من جبال وبحار. ثم تركز على خلق الحياة، من الحيوانات، وصولًا إلى خلق الإنسان فى النهاية.
لنلمس ذلك فى ديوان الشاعر محمد الكفراوى «يكشط العدم بأظافره ويقهقه»، نُتابع فعل الخلق الشعرى مع الكفراوى، الذى يُفعِّل هذا السرد الشعرى عبر الزمن، حيث يُصبح الزمن نفسه عنصرًا من عناصر الخلق، حاضنًا لتكوّن الطبيعة من الكائنات والحيوانات والنباتات، ولتشكّل الجسد البشرى ومعاناته. مع الحروب وأزمات العصر، كلّ ذلك ينسج نسيجًا شعريًا يتداخل فيه الألم بالأمل، وتتداخل فيه الكائنات والعناصر فى صورة أكثر تعقيدًا، أكثر تفتّحًا وتأثُّرًا بتقلبات الزمن. بدءًا من قصيدة «هلم» كنداء للحياة، ثم «دورة التشويش والذكريات» لمحاولة إنقاذ جسد حزين، لجثة مهترئة، «نجوت بأعجوبة».
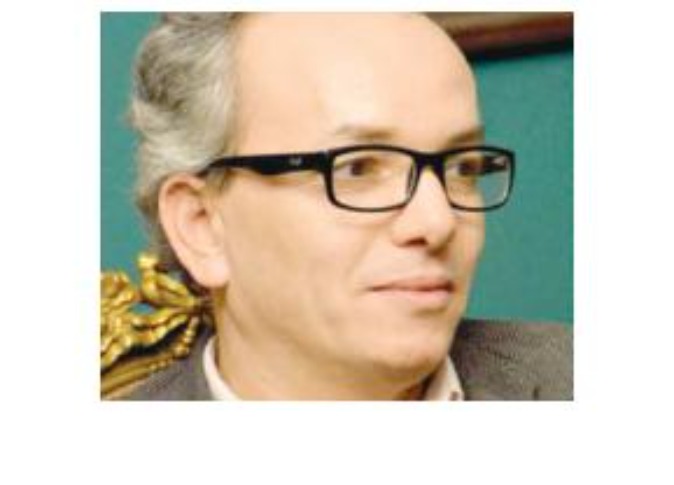 محمد الكفراوى
محمد الكفراوى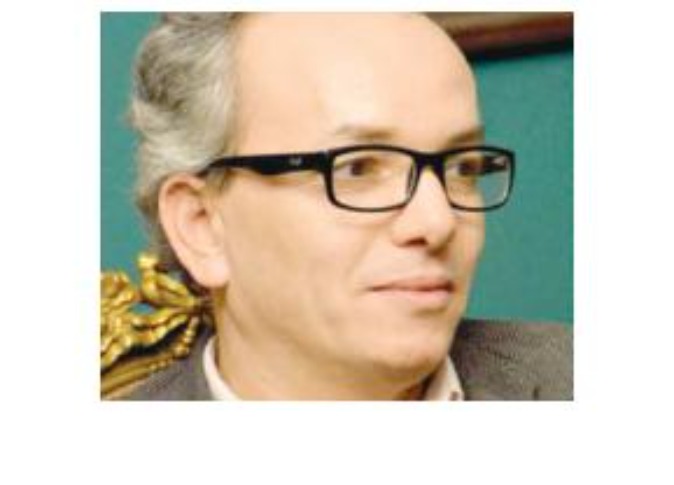
يبنى الشاعر عالمه الخاص بالكلمات والصور والاستعارات. اللغة الشعرية تتميز باستخدامها المكثف للاستعارات والرموز والتشبيهات والتجسيد، مما يسمح بتجاوز الواقع وكشف ما هو مخفى خلفه. «لندبة فى مشاعر اندلقت هناك على الرصيف» إلى خلل فى المقادير، فى الضمائر. ونلاحظ كيف أن الجسد يتحوّل إلى محور مركزى فى النصوص، إذ تتكرّر مفردة «الجسد» بطريقة شبه منتظمة، فى كل جزء وكل نَفَسٍ من القصائد. لكن هذا الجسد لا يظل محصورًا فى ذاته، بل يتجاوز الرؤية الفردية ليتصل بالمحيط، بالحيوانات، بالنجوم، بالطبيعة، وحتى بتاريخ الإنسان. إنه جسد ينزف من الحروب، من الموت، من الغياب، ليصبح جسدًا حزينًا يحمل ذاكرة الجراح والمآسى. ومن هنا، تتحوّل هذه القصائد إلى محاولة لإنقاذ هذا الجسد من الفناء، ليعود ويبدأ من جديد دورة الخلق، بشوق للحياة، ورغبة بالخلود. فى «كيف انتصرت على مدينة من الحمقى بقبضة صدئة»، إنها قصائد تتحدث عن الدم، عن الندوب، عن آثار العنف، لكنها تسعى فى النهاية إلى خلق توازن داخلى وخارجى، وإلى نهاية متفائلة، رغم كل الانهيارات، رؤية تحتضن الجمال فى المدن، فى الأجساد، فى الرغبات، فى الانطفاء والاشتعال.
