تسارع التغيرات في الواقع… وغياب علم الاجتماع
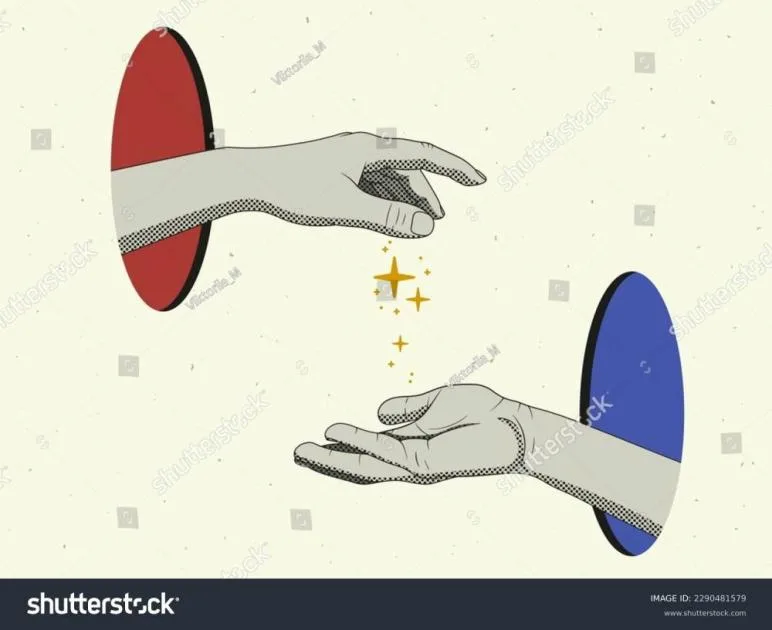
في وقت سابق في مطلع التسعينات من القرن الماضي، أراد عالم الاجتماع والمفكر الفرنسي الشهير بيير بورديو، أن يعيد الاعتبار لعلم الاجتماع الذي يبدو أنه قد تراجع كثيراً عن دوره في ممارسة تحليل الظواهر الاجتماعية، وكان السبيل إلى ذلك أن قام ذلك المفكر الاجتماعي بإجراء مجموعة من الأبحاث الميدانية حول إشكالية البؤس في المدن الكبيرة الفرنسية.
لم يكن ذلك ممكناً لبورديو لولا أنه جرب تطبيق أسلوب جديد في إجراء المقابلات الميدانية، متجاوزاً بذلك – و بشكل ممنهج – قواعد المنهج العتيقة، المتداولة والشائعة في السيسيولوجيا تحديداً، مثل: البناء المسبق للموضوع وصياغة الفرضيات، إشكالية حياد الباحث و ضرورة توظيف منهج تحليل المحتوى «المضمون» على معطيات الدراسة، وكانت نتيجة تلك الجهود كتاب بعنوان «بؤس العالم»، والذي يعد الآن من مراجع كتب الاجتماع، ما يشير إلى أهمية أن تجدد العلوم نفسها وأن تلتقي بأشكال المعارف الأخرى.
ولعل قريباً من ذلك الذي جرى في الغرب ما حدث بالفعل في العالم العربي، والذي يبدو أن علم الاجتماع قد تراجع فيه كثيراً خاصة مع التحولات والمتغيرات الكبرى التي جرت في العصر الحديث، والواقع أن هذا العلم لم يتجاوب مع ما يجري في كل المجتمعات من متغيرات، وربما ذلك ما دفع الغرب نفسه للاعتراف بوجود أزمة في مجال العلوم الاجتماعية داعياً إلى تغيير الأدوات والمفاهيم مثل ما فعل بورديو وغيره، ولئن كان ذلك واقــــع الحــــال فـــي الغــــرب الذي تتجدد فيـــه العلوم والمناهج، فإن هذه الأزمة تتعزز في العالم العربي لجملة من الأسباب المتعلقة بحرية البحث، وبشكل أساسي بالتحام علم الاجتماع لدينا بذات الأفكار والمناهج الغربية، وهو الأمر الذي يتطلب جهداً إضافياً لصنع طريق خاص ينظر إلى الواقع الاجتماعي في بلدان المنطقة بعين عربية من أجل معالجات للظواهر نابعة من صميم الواقع.
ويقر العديد من علماء وخبراء علم الاجتماع العرب بوجود مشكلة حقيقية، كان لها آثارها المتنوعة في عدم اللحاق بالتطورات المتسارعة بفعل المتغيرات العصرية مع ثورة التكنولوجيا والتحديث، إذ إن المناهج التعليمية نفسها لم تسعف في تطور ذلك العلم، لكونها تقليدية ولا تستطيع أن تستجيب لما يحدث من متغيرات، كما أن جميع الدراسات الاجتماعية التي قدمت في العالم العربي كانت تعالج قضايا محدودة، ولا تزال تفعل ذلك، كما أشار بعض الاجتماعيين إلى أهمية أن يطول البحث والتأمل والتفكير علم الاجتماع نفسه وليست ممارسته فقط، من أجل إيجاد تعريف جديد له، فهناك من يجد مفارقة في كون هذا العلم له جذوره القديمة في التراث العربي مع أفكار واجتهادات علماء مثل ابن خلدون الذي كان يطلق عليه علم العمران، وبين تغريب العلوم الاجتماعية على مستوى المنهج والأساليب والأدوات ما يحيل إلى وجود فجوة وقطيعة معرفية.
عولمة
والواقع أن متغيرات كبيرة قد طرأت على البلدان العربية مجتمعة من ظهور العولمة والتطور الكبير في وسائل الاتصال وظهور ما بات يعرف بمواقع التواصل الاجتماعي التي أضحت ملاذاً للجميع، ولئن كانت منتجات ثورة التكنولوجيا قد أحدثت الكثير من المتغيرات على مستوى العادات والسلوكيات وانسحاب الحياة الجماعية، فإنها قد وظفت أيضاً في عمليات التغيير السياسي على نحو ما جرى في ما سمي بالربيع العربي وغير ذلك من منعطفات اجتماعية كبيرة، حيث سادت الحياة الفردية والعزلة والاغتراب عن الواقع، والهجرة إلى بلدان الغرب، وكل تلك إشكالات اجتماعية تنتظر أطروحات وصياغات نظرية من قبل علماء الاجتماع الذين ينصرف بعضهم لقضايا إما قديمة أو غير ذات أهمية قياساً بالمشكلات الأخرى.
تشابكات
ولئن كان استهلال حديثنا بالاختراق الكبير الذي أحدثه بيير بورديو، فذلك للتأكيد على لحظة مهمة في حراك المجتمعات ودرجة تجاوب العلوم الإنسانية مع ذلك الحراك، فعلم الاجتماع لم يكن وحده في ميدان تلك المعركة، فقد كانت هناك الفلسفة والأدب والعديد من العلوم الحديثة، التي وجهت أدواتها وإمكاناتها نحو رصد الحراك الاجتماعي في متغيراته ومنعطفاته المختلفة، فالأدب، وبصورة خاصة السرد سواء الرواية أو القصة، ظل شديد الالتصاق بالواقع الاجتماعي وامتلك القدرة على التعبير عن قضايا البشر اليومية والملحة في كل مكان، وربما ذلك ما أدى للحظة لقاء حتمي بين الأدب وعلم الاجتماع فظهر ما بات يعرف بـ«علم اجتماع الأدب»، ويدرس الإنتاج الاجتماعي للأدب، ومن أشهر المؤلفات التي بحثت في ذلك العلم كتاب «قواعد الفن: تكون بنية الحقل الأدبي»، لبيير بورديو والذي يغوص في تلك العلاقة بين الحقلين الأدب والاجتماع.
ولعل السرد في العالم العربي كان ملتصقاً بالواقع الاجتماعي، فعبرت الرواية ومعها القصة في أوقات سابقة عن المتغيرات الاجتماعية، غير أن ما يحدث اليوم من ظواهر ومنعطفات اجتماعية كبيرة نتاج العولمة والتكنولوجيا لم تجد الكثير من الرصد الأدبي الاجتماعي؛ أي لم تتحول إلى إبداعات سردية، بل يبدو أن هناك هروباً نحو كتابات ربما لا تنتمي إلى الواقع مثل القصص البوليسية وروايات الرعب والجريمة والخيال العلمي، ما يشير إلى أن هناك فجوة كبيرة تنتظر من يملؤها.
ظواهر وقضايا
من المؤلفات الاجتماعية اللافتة والتي تقدم رؤية شاملة للعالم العربي في اتجاهات متعددة، كتاب «المجتمع العربي المعاصر.. بحث في تغير الأحوال والعلاقات»، لعالم الاجتماع حليم بركات، حيث يشتمل الكتاب على إضاءات مهمة في العديد من المواضيع التي يتناولها، فهو يبحث في مجموعة من المسائل التي تطرحها مهمات التعامل مع معضلات التنوّع والاندماج الاجتماعي السياسي داخل كل بلد عربي، وفيما بين البلاد العربية.
والكاتب، يصرّ على ضرورة الاعتراف بوجود مختلف النزاعات والتوجّهات التي تتجاذب العرب بين الوحدة والانكفاء الذاتي، بين التقليد والحداثة، بين الغرب والشرق، وبين المستقبل والماضي، وبين الخاص والعام، وبين الانتماء إلى الجماعة والانتماء إلى الأمة، وينظر الكتاب بعين دقيقة إلى تلك الفجوة التي يعيشها العرب بين طموح السعي نحو التغيير في بدايات القرن العشرين وما يجري حالياً، ويشير إلى التفكك والتشرذم وكل أشكال الاغتراب التي تعيشها المجتمعات العربية في الوقت الراهن، وينعطف نحو الإحساس بالهزيمة السائد في عصر العولمة وما بعد الحداثة والتحولات الاقتصادية والثقافية العالمية وما يرافق ذلك من اتساع في الفجوات بين الأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء والعودة إلى الانتماءات التقليدية.
ويتناول الكتاب الظواهر والقضايا والمسائل العربية الشائكة في سياقها الاجتماعي والتاريخي، ويقدّم لها تفسيراً بنائياً، حيث يركز على دراسة البنية الطبقية والاختلاف في أنماط المعيشة، وما يترتب على ذلك من تنوّع في التنظيم الاجتماعي، ويسعى الكتاب كذلك إلى دراسة الثقافة بمختلف تشعباتها وتنوعاتها، كما يتناول قضايا مستقبلية تتعلق بالتغيير، ومن خلال ذلك كلّه، قصد تلمّس مختلف جوانب التحوّلات في البنى الاجتماعية.
اتبع الكتاب نهجاً مختلفاً، أو ما أطلق عليه المؤلف: «المنهج الاجتماعي التحليلي النقدي»، في سياق البحث حول طبيعة المجتمع العربي بهدف التعرف إلى مقوماته الأساسية ومؤسساته وتنظيمه الاجتماعي في بناه التحتية والفوقية الظاهرة والخفية وثقافته بمختلف تفرعاتها واتجاهاتها، وقضاياه وانشغالاته، وتناقضاته في علاقته بذاته وبالآخر، وتحولاته الدائمة، ومن بين أهم الخلاصات التي توصل إليها الكتاب أن المجتمع العربي مغترب عن ذاته ويسعى جاهداً لتجاوز اغترابه وتبعيته وأزمة المجتمع المدني، رغم ما يفرضه عليه زمن العولمة من تحديات قديمة وجديدة، حيث يبرز المؤلف أهم أشكال تلك التحديات والسبل نحو تجاوزها عبر أفق وتفكير جديد.
ومن ثم يدلف الكتاب نحو دراسة «السمات العامة للمجتمع العربي»، وظواهر مثل التبعية والبنية الطبقية والتعددية الاجتماعية، ويتناول الكتاب كذلك مقومات المجتمع العربي من حيث البيئة والسكان، كما يتبحر في قضايا مثل الهوية والدولة، ويخلص إلى أن المجتمع العربي ليس ساكناً بل هو متطور ومتحول في هويته وثقافته ومفاهيمه وأنظمته بحسب أوضاعه وظروفه ومواقعه وصراعاته المستجدة، كما يلفت الكتاب إلى أنه وبقدر ما يزداد الاندماج في النظام العالمي كلما برزت التناقضات، حيث إن المؤلف يشير إلى أن الصراع مع الغرب ليس في الأساس تصادماً حضارياً ودينياً كما يدعي البعض أمثال صموئيل هانتغنتون، بل هو ناتج عن التناقضات في المصالح والمواقع ومن علاقات القوة التي يمارسها الغرب على العرب في فرض هيمنته من خلال العولمة وغيرها.
كما يتناول الكتاب قضية «التواصل والاتصال بين البلدان العربية في زمن العولمة والثورة الإعلامية»، ويغوص في قضايا الاقتصاد والعلاقات مع دول العالم المختلفة والتحديات الخارجية وإذا ما كانت عامل وحدة أم تجزئة، ويتبحر في قضية الحداثة وموقف العربي منها ومن منجزاتها في مجال التكنولوجيا.
حزمة أسئلة
لعل من أهم المؤلفات الاجتماعية الأدبية التي تغوص في العلاقة بين الحقلين كتاب «علم اجتماع الأدب»، للكاتبين د. محمد سعيد فرح ومصطفى خلف عبد الجواد، وهو دراسة مهمة في الميادين التي تجمع بين الاجتماع كعلم، والأدب، والعلاقة المتبادلة بينهما، ولئن درج بعض النقاد على تعريف علم اجتماع الأدب على أنه دراسة للأعمال والنصوص الإبداعية من وجهة ومنظور علم الاجتماع، فإن هناك من يشير إلى أن تلك المنتجات الأدبية في مجالات السرد والشعر والمسرح وغير ذلك، تعين في فهم الحياة الاجتماعية، وتلك نقطة تجد مساحة مقدرة من الكتاب، حيث تغوص في شرح تناول الأعمال الأدبية للواقع الاجتماعي وظواهره المختلفة.
يتكون الكتاب من ثمانية فصول، حيث يتناول الأول «علم اجتماع الأدب ماهيته وفروعه»، ويقدم قراءة حول مواضيع وميادين علم الاجتماع، ويجيب عن سؤال: «لماذا علم اجتماع الأدب؟»، فيما يتناول الفصل الثاني «علم اجتماع الأدب… البدايات الأولى والمداخل الأساسية»، ويبحث في كيفية تشكل هذا العلم ولحظاته الأولى، ويركز على مداخل أساسية مثل دراسة الأدب كانعكاس للعصر، أما الفصل الثالث فهو يركز على «النظريات الاجتماعية للأدب»، بينما يتناول الرابع «طرق البحث في علم اجتماع الأدب»، بينما يغوص الفصل الخامس في ثنائية «الأدب والمجتمع»، من حيث «الوظيفة الاجتماعية للأدب»، و«العمل الأدبي ظاهرة اجتماعية»، و«الأدب والطبقة»، و«الأدب والأيديولوجيا»، بينما يطل الفصل السادس على «الحركات المعاصرة في علم اجتماع الأدب»، فيما يركز الفصل السابع على «الحياة الأسرية في المجتمع المصري الحديث كما عكستها الأعمال الروائية»، حيث يتناول الحياة الأسرية في المجتمع الحديث، أما الفصل الثامن فهو يتحدث عن «الشخصية المصرية كما عكستها الأعمال الروائية».
يؤكد الكتاب أن علم اجتماع الأدب إسهام جديد في ميدان علم الاجتماع، وهو ميدان غير تقليدي يحاول أن يحطم الفواصل بين علم الاجتماع والفنون عامة والأدب خاصة، ويؤكد أن ثمة مجالاً مشتركاً بين علم الاجتماع والأدب يستحق الاهتمام ومن ثم الدراسة من أجل فهم أكثر عمقاً لأحوال البشر. وإذا كان رواد علم الاجتماع قد أغفلوا أهمية الدراسة العلمية للفنون عامة والأدب خاصة؛ فإن هذا الاهتمام تزايد بين الباحثين في مجال علم الاجتماع منذ عقد الستينيات.
ومثلما يهتم علم الاجتماع بفهم مكانة الإنسان في المجتمع وعلاقة الإنسان بالآخرين، كما يدرس سلوك الناس في المجتمع، ويكشف عن التزامهم بالمعايير الاجتماعية أو انحرافهم عن هذه المعايير، يحاول علم اجتماع الأدب، كما يبين الكتاب، أن يكشف عن مدى الالتحام والاتصال بين علم الاجتماع والأدب، ويجيب عن السؤال الآتي: أين تكمن العلاقة بين الأدب وعلم الاجتماع؟ ويحيل الكتاب إلى «النظرية الاجتماعية للأدب»، لألن سوينجوود والتي تعنى بدراسة العلاقة بين الأدب والمجتمع، حيث تسعى إلى فهم كيف يعكس الإبداع الظواهر الاجتماعية ويؤثر فيها، ويؤكد سوينجوود أن علم الاجتماع والأدب يكمل كل منهما الآخر، ويساعدان الإنسان على فهم المجتمع والحياة الاجتماعية، إلا أنهما ظلا – تاريخياً – بعيدين عن بعضهما، مثل تباعد علم الاجتماع عن علم النفس، وقد فرض موضوع التخصص والرؤية النرجسية لهذا الموضوع بقاء أسوار عالية تحيط بكل تخصص، وهي أسوار مفتعلة تحجب الرؤية عما يدور في الخارج.
